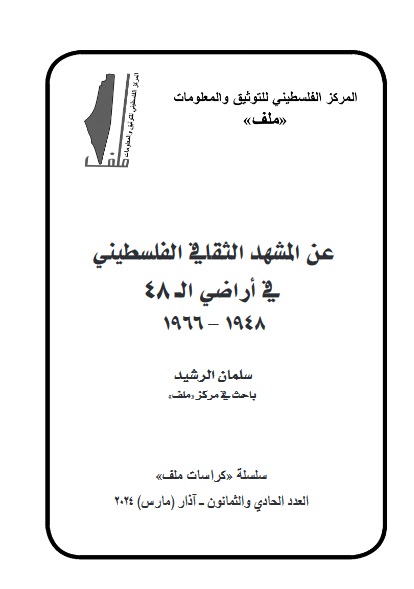
العدد 81 من «كراسات ملف»: المشهد الثقافي في أراضي الـ48 .. 1948 ــ 1966
■ صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات /«ملف»،العدد 81 من سلسلة «كراسات ملف»، ويضم دراسة بعنوان «عن المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ 48.. 1948ـــ 1966» ، أعدها سلمان الرشيد، الباحث في مركز «ملف».
تتناول الدراسة أبرز معالم المشهد الثقافي الفلسطيني في المرحلة الأصعب التي مرت على الفلسطينيين في أراضي الـ48 بعد قيام الدولة العبرية. وهي الفترة الممتدة من تاريخ وقوع النكبة حتى العام 1966، والتي اجتمع فيها عليهم؛ تداعيات هول الكارثة، وتغول القمع الصهيوني عبر وضعهم تحت سطوة قوانين الطوارئ والأحكام العسكرية.
جاء في مقدمة الكراس:
«كان الفلسطينيون في منتهى الضعف و«قلة الحيلة» أمام طغيان قوة غاشمة منتشية بحمى الانتصار على شعب تكالبت عليه قوى الاستعمار العالمي، وتخلى عنه أشقاؤه، وخذلته قياداته المصابة بداء الرهان على أصدقاء عدوه وحلفائه.
لقد أراد قادة الحركة الصهيونية أن يتم توطيد أركان الدولة العبرية وتثبيت دعائمها المفتعلة «على بياض»؛ عبر إزالة آثار من تم تهجيره من فلسطين، فدمروا ما استطاعوا من قراها وحواضرها، وصادروا سجلات أهلها ووثائق ملكية أراضيهم وعقاراتهم؛ وعبر كتم أصداء حياة الفلسطينيين ونبض وجدانهم، فأخفوا ما وقعت عليه أيديهم من أرشيف صحف ومجلات ومؤسسات ثقافية فلسطينية كانت قائمة قبل وقوع النكبة، ووضعوا الفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم، أمام خيارين: إما الخضوع لهذا «الواقع الجديد»، أو الالتحاق بمن سبقهم من المهجرين».
■ تشكل هذه الدراسة فصلاً من عرض مطول، يتناول أبرز جوانب المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ48 منذ وقوع النكبة وحتى اليوم، وهي لا تنحو باتجاه النقد الأدبي المتخصص، بل تسعى إلى تعريف الأجيال الفلسطينية الشابة على المحطات والمراحل التي مر بها المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ48، والذي شكل بفضل صلابة رواده وقوة إرادتهم امتداداً أصيلاً - ومتطوراً - للتجربة الثقافية الفلسطينية قبل النكبة.
■ جاء التحديد الزمني لهذه الدراسة ما بين أعوام 1948-1966، كونها الفترة التي طبقت خلالها قوانين الطوارئ والأحكام العسكرية الصهيونية على فلسطينيي الـ48، وهذا يفيد في تظهير قدرة النخب السياسية والثقافية الفلسطينية - رغم تلك الظروف - على إفشال محاولات قيادة الدولة العبرية إخماد جذوة النهوض الثقافي والمعرفي الفلسطيني، باعتباره أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وانتمائه القومي■
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»
18/3/2022
عن المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ 48
1948 – 1966
سلمان الرشيد
باحث في مركز «ملف»
سلسلة «كراسات ملف»
العدد الحادي والثمانون ــ آذار(مارس)2024
المحتويات
■ مقدمة
1- الحركة الثقافية الفلسطينية قبل النكبة
2- الصدمة وتحدي البقاء
3- النكبة الممتدة فصولاً
4- نوافذ في جدار الحظر
5- في مواجهة القمع والتجهيل
6- ثنائية الالتزام السياسي ــ الاجتماعي
7- مساهمات أولية في المسرح والقصة
8- ملاحظات وخلاصات
مقدمة
■ يتناول هذا الكراس أبرز معالم المشهد الثقافي الفلسطيني في المرحلة الأصعب التي مرت على الفلسطينيين في أراضي الـ48 بعد قيام الدولة العبرية. وهي الفترة الممتدة من تاريخ وقوع النكبة حتى العام 1966، والتي اجتمع فيها عليهم؛ تداعيات هول الكارثة، وتغول القمع الصهيوني عبر وضعهم تحت سطوة قوانين الطوارئ والأحكام العسكرية.
كان الفلسطينيون في منتهى الضعف و«قلة الحيلة» أمام طغيان قوة غاشمة منتشية بحمى الانتصار على شعب تكالبت عليه قوى الاستعمار العالمي، وتخلى عنه أشقاؤه، وخذلته قياداته المصابة بداء الرهان على أصدقاء عدوه وحلفائه.
لقد أراد قادة الحركة الصهيونية أن يتم توطيد أركان الدولة العبرية وتثبيت دعائمها المفتعلة «على بياض»؛ عبر إزالة آثار من تم تهجيره من فلسطين، فدمروا ما استطاعوا من قراها وحواضرها، وصادروا سجلات أهلها ووثائق ملكية أراضيهم وعقاراتهم؛ وعبر كتم أصداء حياة الفلسطينيين ونبض وجدانهم، فأخفوا ما وقعت عليه أيديهم من أرشيف صحف ومجلات ومؤسسات ثقافية فلسطينية كانت قائمة قبل وقوع النكبة، ووضعوا الفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم، أمام خيارين: إما الخضوع لهذا «الواقع الجديد»، أو الالتحاق بمن سبقهم من المهجرين.
■ تشكل هذه الدراسة فصلاً من عرض مطول، يتناول أبرز جوانب المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ48 منذ وقوع النكبة وحتى اليوم، وهي لا تنحو باتجاه النقد الأدبي المتخصص، بل تسعى إلى تعريف الأجيال الفلسطينية الشابة على المحطات والمراحل التي مر بها المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ48، والذي شكل بفضل صلابة رواده وقوة إرادتهم امتداداً أصيلاً - ومتطوراً - للتجربة الثقافية الفلسطينية قبل النكبة.
■ جاء التحديد الزمني لهذه الدراسة ما بين أعوام 1948-1966، كونها الفترة التي طبقت خلالها قوانين الطوارئ والأحكام العسكرية الصهيونية على فلسطينيي الـ48، وهذا يفيد في تظهير قدرة النخب السياسية والثقافية الفلسطينية - رغم تلك الظروف - على إفشال محاولات قيادة الدولة العبرية إخماد جذوة النهوض الثقافي والمعرفي الفلسطيني، باعتباره أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وانتمائه القومي■
(1)
الحركة الثقافية الفلسطينية قبل النكبة
■ تعود أول مطبعة في فلسطين إلى العام 1846، وهي مطبعة رهبان دير الفرنسيسكان، في القدس، ثم انتشرت المطابع لاحقا في باقي المدن الفلسطينية. وبحسب وزارة الثقافة في السلطة الفلسطينية فقد صدر 1400 كتاب ومخطوطة في فلسطين ما بين عامي 1900-1948، تناولت موضوعات في الأدب والسياسة والفلسفة والتاريخ والفقه، ألفها نخبة من المفكرين والمؤرخين والأدباء والباحثين الفلسطينيين. وخلال الفترة ذاتها، صدر في فلسطين نحو 250 صحيفة ودورية، وكانت مدن: يافا، حيفا، القدس، عواصم للصحافة الفلسطينية. وذكر مؤرخون أن صحيفة «الكرمل»- 1908، حيفا، هي أول صحيفة سياسية فلسطينية، وقد صدرت بمبادرة من الصحافي نجيب نصّار. وفي ظل الانتداب البريطاني تطورت الصحافة في فلسطين ضمن تطور الأحداث السياسية فيها، حتى أصبحت تشكل حالة فريدة في بلد محتل لا يزيد عدد سكانه عن 1,5 مليون، منهم 30% أميون، وتصدر فيه 18 صحيفة صباحية و3 صحف مسائية وعدد أكبر من الصحف الأسبوعية والشهرية. وقبيل انتهاء الانتداب- 1948، كانت جريدة «فلسطين»- 1932، هي أقدم الصحف اليومية العربية الأربع، التي كانت ما تزال تصدر في فلسطين. [مهند صلاحات: «الصحافة الفلسطينية ما قبل النكبة»، صحيفة «رمان» الالكترونية- 20/5/2017].
■ يمكن القول إن فلسطين شهدت، خلال العقود التي سبقت النكبة، نهضة ثقافية. وقد تنوع النتاج الثقافي فيها ما بين الشعر والرواية والأدب القصصي والترجمة والمسرح والسينما، وساهمت كوكبة من الشعراء والكُتاب، في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني:
• فمن أبرز الشعراء الفلسطينيين قبل النكبة: إبراهيم طوقان(1905-1941)، مطلق عبد الخالق (1910-1937)، عبد الرحيم محمود (1913-1948) وعبد الكريم الكرمي/أبو سلمى (1911-1984)، فدوى طوقان (1917-2003)، حسن البحيري (1921-1998).
• وتُنسب لخليل بيدس (1875-1949)، أوّل رواية فلسطينية معروفة وهي «الوارث» - القدس ، 1920، تلاه إسحاق موسى الحسيني (1904-1990)، برواية «مذكرات دجاجة»- 1943، وقد كتب مقدمتها عميد الأدب العربي طه حسين. وكتب بيدس أيضاً قصصاً قصيرة، ونشر أوّل مجموعة بعنوان «آفاق الفكر»- القاهرة ، 1924، وتبعه في هذا المضمار أحمد شاكر الكرمي
(1894-1927).
• وترجم بيدس مباشرة عن الأدب الروسي، أو عن ترجمات روسيّة لكتّاب مثل ماري كوريلّي وفيكتور هيغو، وترجم الكرمي عن الإنكليزية أعمالاً لأوسكار وايلد ومارك توين، كما ترجم عن ترجمات إنجليزية لأعمال كتّاب أوروبيين مثل غي دو موباسان، وبيرنردان دي سان بيير، وتولستوي، وتشيخوف، وترجم عادل زعيتر(1895-1957)، عدة كتب منها: «روح الشرائع» لمونتسكيو، «العقد الاجتماعي» لروسو، و«حضارة العرب» لغوستاف لوبون، كما برز اسم عنبرة سلام الخالدي (1897-1986)، كأوّل مترجمة فلسطينية، مع ترجمتها «الإلياذة» لهوميروس. [أنطوان شلحت: «بالمعطيات الجـافّة: النهضة الثقافية في فلسطين قبل النكبة» ــ موقع «ضفة ثالثة» الإلكتروني، 23/5/2018].
• ونشط في فلسطين عدد من المسرحيين ما بين عامي 1919 و1948، في مقدمتهم جميل البحري (1895-1930)، الذي ألف برغم وفاته شاباً، 12 مسرحية، حتى لقب بـ«أبو المسرح»، وبرزت في هذا المجال أسماء مثل: برهان العبوشي (1911-1995)، محمد حسن علاء الدين (1917-1973)، ومحي الدين الحاج عيسى (1900-1974). وتأسست جمعيات وفرق مسرحية كثيرة منها: «التمثيل الأدبي»، «الفنون والتمثيل» «النادي العربي» - القدس، جمعية «الشبّان المسلمين» - يافا، «نادي الشبيبة» - بيت لحم و«نادي الشبيبة الأرثوذكسية» - غزة.
• وفي مجال السينما، كان إبراهيم حسن سرحان أول فلسطيني يصنع فيلماً توثيقياً ــ 1935، تلاه كل من: جمال الأصفر، خميس شبلاق، أحمد حلمي الكيلاني، محمد صالح الكيالي.
[مهند إبراهيم أبو لطيفة،«الثقافة في فلسطين قبل النكبة» صحيفة «رأي اليوم»- 15/6/2019] ■
(2)
الصدمة وتحدي البقاء
■ إنهار المجتمع الفلسطيني بفعل النكبة، وتحولت بنيته الاجتماعية الأساسية مجموعات متفرقة من اللاجئين، بعد أن قذفت الآلة العسكرية الصهيونية بنحو 750 ألف فلسطيني خارج أرضهم وممتلكاتهم. وبقي 158 ألف فلسطيني في وطنهم، معظمهم من سكان القرى، من بينهم 25 ألفاً أقاموا خارج قراهم إثر تدميرها على يد العصابات الصهيونية. فيما تحول أهالي المدن الفلسطينية مثل حيفا ويافا وعكا وصفد وطبريا واللد والرملة وبئر السبع إلى أقليات فيها وسط أغلبية يهودية وافدة.
وخلال السنوات الأولى من الاحتلال، وجد الفلسطينيون أنفسهم في عزلة شبه تامّة عن محيطهم العربي، في ظل إغلاق الحدود، وانعدام وسائل الاتصال والتواصل، من هاتف وبريد، وحظر لوصول الصحف والمجلات من الدول العربية، وندرة في أجهزة المذياع التي يمكن بواسطتها تتبع أخبار ما يجري من حولهم.
■ وتحت وقع كارثة النكبة، تلاشى المشهد الثقافي الذي كان قائماً في فلسطين دفعة واحدة ، بعدما انهارت بناه ومنابره وتشتت مبدعوه ونشطاؤه. عن ذلك يقول غسان كنفاني: «حين سقطت فلسطين في يد العدو لم يكن قد بقي تقريباً في فلسطين المحتلة أيّ محور ثقافي عربي يمكن أن يشكّل نواة لنوع جديد من البعث الأدبي، وكان جيل كامل من المثقفين، أو بالأحرى أجيال من المثقفين، قد غادرت فلسطين إلى المنفى».. ولعل الشاعر حنا أبو حنا (1928-2022)، الذي كان في مقتبل شبابه عند وقوع النكبة كان أبلغ من عبر لاحقاً عن حجم الكارثة عندما قال: «كلّ ما كان أرضاً نقف عليها انخسف هوّة في الأرض، وكلّ ما كان معتمداً ومتّكأً تهشّم كقصبة جوفاء».[غسان كنفاني: «أدب المقاومة في فلسطين .. 1948- 1966، ص11].
■ لكن ماوقع لم يكن النهاية كما أرادت المؤسسة الصهيونية. فهاهو الشاعر سالم جبران، الذي لاينكر فداحة ماجرى، يعلن للاحتلال أنه مازال رغم كل شيء حراً وسيداً في أرضه.. وسيبقى كذلك. فيقول:
يمكنكم أن تقلعوا الشّجر
من جبل في قريتي
يعانق القمر
يمكنكم أن تحرثوا كلّ بيوت قريتي
فلا يظلّ، بعدها أثر
يمكنكم أن تأخذوا ربابتي وتحرقوها بعد أن تقطعوا الوتر
يمكنكم..
لكنّكم لن تخنقوا لحني
لأنّي عاشق الأرض مغنّي الرّيح والمطر■
(3)
النكبة الممتدة فصولاً ..
■ رأت قيادة المشروع الصهيوني أن للنكبة الفلسطينية فصولاً أخرى ينبغي استكمالها، تحت غطاء سياسة مزدوجة، يروِّج شقها الدعائي على تسويق «واحة الديمقراطية»، التي تجسدها إسرائيل في المنطقة، من زاوية «احتضانها» من تبقى من الفلسطينيين تحت سلطتها، ومنحهم «حقوق المواطنة». فيما كان الشق العملي يتركز في الضغط عليهم كي يلتحقوا مرغمين بمن سبقهم على طريق اللجوء، وقد اعتبرتهم قيادة الدولة العبرية «خطراً أمنياً ووجودياً»، وفرضت عليهم حكماً عسكرياً(1948- 1948). وبموجبه، أُخضع الفلسطينيون لرقابة أمنية مشددة قَيَّدت حركتهم، وحصرتها بتصاريح مسبقة. وقد كشف المؤرخ الإسرائيلي يئير بويمل أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لسياسة ترمي إلى «مصادرة 60% من أراضي العرب؛ منع عودة المهجرين إلى قراهم؛ منع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم؛ إقامة بلدات يهودية في قلب التجمعات السكانيّة العربية؛ الحيلولة دون قيام وجود منظّم ومستقلّ للنشاط الجماهيريّ والاجتماعيّ والثقافي؛ منع النشاط السياسيّ العربيّ الداخلي المستقل؛ تعميق التصدّعات والانشقاق في صفوف العرب أوخلق تصدّعات جديدة، إلغاء تعريفهم وهويتهم ومنع بلورّة هوية قومية جماعية لهم،..».
وكان الحكم العسكري «يتدخّل في حياة المواطن العربي منذ ولادته حتى وفاته. فهو يملك القرار الأخير في قضايا العمّال، الفلاحين، الحرفيّين، التجّار، المثقّفين، وفي شؤون التربية والخدمات الاجتماعيّة. كما يتدخّل أيضاً في قضايا تسجيل السكاّن، الولادات، الوفيات، وحتى الزواج، وفي قضايا الأراضي، وتعيين وإقالة المعلّمين والموظّفين. ويكثر من تدخّله التعسّفي أيضاً في شؤون الأحزاب السياسيّة والنشاطات السياسيّة والاجتماعيّة، وفي المجالس المحليّة والبلديّة». [يئير بويمل، «الحكم العسكري»، ص 59-86، من كتاب «الفلسطينيون في إسرائيل»، مدى الكرمل، حيفا /2015].
■ سمحت الإدارة الصهيونية لفلسطينيي الـ48 بالمشاركة في انتخابات الكنيست منذ محطتها الأولى- 1949 ، بهدف وضع حراكهم السياسي تحت مجهر المتابعة، وتوجيهه بما لايتعارض ومتطلبات توطيد أركان الدولة العبرية في فلسطين. واستثمرت حالة انهيار البنى السياسية والحزبية الفلسطينية، فتعاملت مع الفلسطينيين كخزان أصوات انتخابية، تعزز موقع الأحزاب الصهيونية الكبيرة في مؤسسات الدولة العبرية. وفي سياق تحقيق ذلك، منعت السلطات الإسرائيلية قيام تنظيم عربي مستقل.
وكان حزب «عمال أرض إسرائيل»/«ماباي»، سباقاً في تشكيل «قوائم عربية» مساندة للحزب في الانتخابات، واعتمد في تشكيلها على زعامات محلية ذات طابع حمائلي وطائفي وجهوي ومناطقي، وفقاً للتقسيم الصهيوني لفلسطينيي الـ48، الذي لايعترف بهم كأقلية واحدة بل أقليات جماعاتية متعددة (درزية، مسيحية، بدوية، مسلمة..). مقابل بعض الامتيازات التي يمنحها من موقعه في السلطة، لأعضاء هذه القوائم الذين يتعامل معهم كـ «مقاولي أصوات» لصالحه. وفي سياق هذه الامتيازات، يتم تعزيز موقع هؤلاء من خلال تسهيلات لجمهورهم الانتخابي (تصاريح عمل وتنقل..) في ظل حالة الطوارئ، وبذلك، يضمن في الوقت نفسه إطاراً يستعين به لتمرير إجراءاته وسياساته في أوساط المجتمع العربي، بما في ذلك الوسط الثقافي.[للمزيد؛ محمد السهلي: «الأحزاب العربية في إسرائيل»، ص 203-232، من كتاب «بين مشهدين»، الرقم 42 من سلسلة «على طريق الاستقلال»، إصدار المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»، ط5:1/2022]■
(4)
نوافذ في جدار الحظر
■ صادرت السلطات الصهيونية أرشيف الصحف والمجلات والروابط والمؤسسات الثقافية الفلسطينية، واستولت على مقرات ومعدات عدد منها، مثل صحيفة «فلسطين» ومطبعتها في يافا، من أجل إصدار صحيفة «اليوم» الناطقة بالعربية والموالية لحزب «ماباي» الحاكم. وكما حظرت القوانين الصهيونية في تلك الفترة، تشكيل أحزاب وحركات سياسية بهوية عربية مستقلة، منعت أيضاً صدور أية مطبوعات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تعبر من قريب أو بعيد عن هذه الهوية الوطنية الفلسطينية أو تنشر عن أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل خارج الرواية الصهيونية.
■ يذكر في هذا المجال أن «حركة الأرض» التي تأسست عام 1959 ولم يُوافق على ترسيمها، قدمت طلباً لترخيص جريدة تخصها، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت، لأن برنامج الحركة وأهدافها «تمس بأمن إسرائيل». فأصدرت الحركة نشرات متوالية بأسماء فردية مختلفة، وهو ما يسمح به القانون الإسرائيلي للنشر شرط أن يتم لمرة واحدة كل عام. لكن مضمون هذه النشرات استفز السلطات الإسرائيلية، فأغلقت مقر النشرة وصادرت أعدادها وقدمت محرريها إلى المحاكمة، ومن بينهم: حبيب قهوجي، منصور كردوش، صبري جريس. ثم قررت السلطات الصهيونية، ملاحقة الحركة ومصادرة أملاكها باعتبارها «خارجة على القانون».
■بالمقابل، وخلال فترة الحكم العسكري، أصدرت الأحزاب الصهيونية مجموعة من الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية الناطقة باللغة العربية، ومهمتها الترويج لسياسات هذه الأحزاب، بهدف السيطرة على الوعي الفلسطيني في أراضي الـ48. من بين هذه الصحف: «المرصاد»/سياسية ،«الفجر»/ شهرية أدبية لحزب «مابام»، «الأمل» لحزب «أحدوت هعفوداه»، «المركز» لحزب «الصهيونيين العموميين». ومثلما وظف حزب «ماباي» الحاكم نفوذ زعامات إقطاعية وعشائرية في خدمة مصالحة الانتخابية في الكنيست، حاول أن يستفيد ممن هم تحت تأثيره في الوسط الثقافي، في محاولة للتغطية على خطاب التمسك بالأرض والهوية ورفض سياسات التهميش والتمييز بحق الفلسطينيين، الذي تزخر به قصائد وكتابات الغالبية الساحقة من الشعراء والأدباء الفلسطينيين، ففتح أمام المنتفعين أبواب النشر في صحيفته. وعن ذلك يقول الشاعر والكاتب جمال قعوار: «كلما حاولت السلطات أن تستخلص أدبا ما من مأجوريها كانت تصدم بالابتعاد من قبل الأوساط العربية، لأن مضمونه بعيد عن أية آمال لأبناء الشعب العربي هنا، حيث يبث الروح العدمية بين الجماهير العربية».
■ أصدرت «عصبة التحرر الوطني الفلسطيني» صحيفة «الاتحاد»- 1944، والتي باتت في العام 1948 صحيفة أسبوعية ناطقة باسم الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وقد مكَّن برنامج الحزب المناهض للصهيونية وعضويته المختلطة بين العرب واليهود، في أن تجد قضايا المجتمع العربي في إسرائيل مكاناً على صفحات الجريدة، التي أصدرت ملحقاً ثقافياً، تحول إلى مجلة ثقافية شهرية باسم «الجديد» ــ 1954، شكلت منبراً لعدد من الكتاب والشعراء الفلسطينيين، خاصة أن الحزب كان يضم صفوفه و في منابره الصحفية عدداً واسعاً من المثقّفين والمبدعين الفلسطينيين البارزين، بدأ معظمهم نشاطه الفكري والأدبي منذ أواخر عهد الانتداب البريطاني، منهم: جبرا نقولا
(1906-1974)، إميل توما (1919-1985)، إميل حبيبي (1921-1996)، صليبا خميس (1924-1990)، عصام العبّاسي (1924-1989)، حنا إبراهيم (1927-2020)، حنا أبو حنا (1928-2022)، توفيق زياد (1929-1994)، عيسى لوباني (1932-1999)، سميح القاسم (1939-2014)، محمود درويش (1941-2008)، سالم جبران (1941-2011). [سليمان جبران: «مدخل لدراسة الشعر الفلسطيني في إسرائيل .. 1948-1967»- الحوار المتمدن، 8/ 2012] ■
(5)
في مواجهة القمع والتجهيل
■ شكلت سياسة التجهيل رأس حربة الاضطهاد الثقافي الصهيوني للعرب في أراضي الـ48، من موقع إدراك المؤسسة الصهيونية أهمية التعليم والثقافة في الحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين وحمايتها من الاندثار. ويبدأ تنفيذ هذه السياسة باستبدال المعلمين القدامى بمدرسين محدثين لا يتمتعون بالتأهيل التربوي اللازم، لأن القدامى بتجربتهم الغنية وكفاءتهم التعليمية يشكلون جسراً ينقل إلى عقول الجيل الجديد الوعي بتاريخ شعبه وثقافته الراسخة.
ويشير غسان كنفاني (1936-1972)، إلى إحصائية إسرائيلية تفيد بأن «53% من المعلمين العرب في إسرائيل، غير مؤهلين». وتذكر هذه الإحصائية أن «75% من الجيل العربي الذي بدأ التعليم في الصف الأول عام 1957، تركوا المدرسة في العام 1964، أي قبل أن يصلوا الصف الثامن»، وأن «نسبة نجاح الطلبة العرب في امتحانات الشهادة الثانوية عام 1964 لم تتجاوز 10%». وقد كشفت «حركة الأرض» في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت- 1964، تعرض فيها لأوضاع العرب في إسرائيل، أن هذه النسبة خادعة، على ضآلتها، حيث لم تتجاوز في الحقيقة الـ 5%، وهذا ما يفسر أن مجموع الطلاب العرب في الجامعات في اسرائيل، عام 1967، كان 200 طالب فقط، مقابل 19 ألف طالب جامعي إسرائيلي، [غسان كنفاني، «الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال.. 1948-1968»، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت- 1968، ص 19].
■ وخلال فترة الحكم العسكري، فرضت الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة رقابة صارمة على المؤسسة التعليمية، ولاحقت كلّ من لا يدين لها بالولاء من المعلّمين، فأشاعت بينهم جواً من الإرهاب والتهديد. وبما أن معظم الكتاّب والشعراء آنذاك عملوا في سلك التعليم، فكان أمام المعلم، الكاتب أو الشاعر، واحدة من اثنتين: إمّا كتابة ما لا يؤذي ولا يغضب بعيداً عن القضايا السياسيّة والوطنيّة، وإمّا المجازفة بكتابة ما تجيش به نفسه، باسمه الصريح حينًا والمستعار غالباً، معرّضاً نفسه للفصل من الوظيفة وحرمانه من لقمة العيش. وذلك في فترة قلّت فيها الأعمال وعزّت الوظيفة في غير مجال التعليم.
ولقد تعرض عدد كبير من الكتاب والشعراء والصحفيين الفلسطينيين لإجراءات الطرد من وظائفهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم بسبب مواقفهم، وزج بالكثير منهم في السجون. ومن بينهم: توفيق زياد، راشد حسين، فوزي الأسمر، محمود درويش، سميح القاسم. منصور كردوش، صالح برانسي، فخري جدي، حبيب قهوجي، سالم جبران، صبري جريس، عبد الحفيظ درواشة، فرح نور سلمان، علي رافع، علي عاشور، زاهي كركبي، نصري المر، جورج غريب، فؤاد خوري. [سليمان جبران: مصدر سابق].
■ ويعبَّر سميح القاسم عن غضبه وتحديه لإجراءات القمع والتضييق الصهيونية، قائلاً في قصيدته «خطاب من سوق البطالة» - 1958:
سأعرض للبيع ثيابي وفراشي
ربما أعمل حجاراً.. وعتالاً.. وكناس شوارع
ربما أبحث، في روث المواشي، عن حبوب
ربما أخمد.. عرياناً.. وجائع
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم.
■ فيما يخاطب الشاعر الشاب راشد حسين حبيبته، التي بثته مخاوفها ممن يترصدونه وهو الذي لم يأبه للتهديدات بالاعتقال، إن لم يتوقف عن كتابة قصائده في تمجيد شعبه وحقه في الحياة الحرة، فيقول:
قالت أخاف عليك السجن.. قلت لها
من أجل شعبي ظلام السجن يُلتحف
لو يقصرون الذي في السجن من غرف
على اللصوص لهدت نفسها الغرف
لكن لها أمل ان يستضاف بها
حرُّ فيعبق في أنحائها الشرف.
■ ومن السجن كتب محمود درويش أروع قصائده و أكثرها امتلاءً بالأمل والاصرار والتحدي، هازئاً من سجانه ومعتزاً بقيده الذي يرى فيه مايؤكد جدارته بالحرية:
من آخر السجن طارت كف أشعاري
تشد أيديكم ريحاً على نار..
أقول للمُحكم الأصفاد حول يدي:
«هذى أساور أشعاري و إصراري!»
في حجم مجدكم نعلي، و قيد يدي
في طول عمركم المجدول بالعار..
في اليوم أكبر عاماً في هوى وطني
فعانقوني عناق الريح للنار!
■ ويبلغ التحدي أوجه عند الشاعر توفيق زياد، وهو الذي تعرض للسجن عدة مرات بعد أن طُرد من وظيفته فيقول:
هنا على صدوركم باقون كالجدار
نجوع .. نعرى .. نتحدى
ننشد الأشعار
ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات
ونملأ السجون كبرياء
ونصنع الأطفال .. جيلاً ثائراً .. وراء جيل
كأننا عشرون مستحيل
في اللد والرملة والجليل■
(6)
ثنائية الالتزام السياسي - الاجتماعي
■ لقد أدت السياسات الصهيونية اليومية ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى حسم موضوعة الالتزام في الأدب الفلسطيني، حيث «لم تكن قضية الأدب الملتزم بين الغالبية الساحقة من أدباء فلسطين المحتلة موضع جدل، لأن الجدل فيها، أمام التحديات اليومية الخطيرة، يشكل رفاهاً لم يقبله أحد». [غسان كنفاني، مصدر سابق]. وقد تبلور هذا المفهوم في أعمال الكتاب والشعراء الفلسطينيين بدءاً من النصف الثاني من خمسينيات ق20.
فبينما غلبت القضايا الذاتية والغزل على قصائد المهرجان الشعري الفلسطيني الأول، الذي نظمته جمعية «الشبّان» المسيحية – الناصرة 3/1955، تغير الأمر تماماً بعد سنوات قليلة، فقد أقامت «رابطة الأدباء والمثقفين العرب»- 9/1957، مهرجانات شعرية في الناصرة، وحيفا، وعكا،.. وسادت قصائدها القضايا والطموحات الوطنية والقومية للفلسطينيين. ومع تصاعد الأحداث في فلسطين ومحيطيها العربي والدولي، تحوّلت هذه المهرجانات إلى تظاهرات أدبية وسياسية، لها جمهورها الواسع. ولعلّ خير دليل على أهمية هذه المهرجانات وأثرها أنّ السلطات الصهيونية ضاقت بها ذرعاً، فأوعزت إلى أجهزتها الأمنية أن تعمل على إفشالها أو الحؤول دون انعقادها.
■ لم يقتصر مفهوم الالتزام في الأدب الفلسطيني في تلك الفترة على تناول القضايا الوطنية بإطارها السياسي، بل تناول الشعراء والكتاب قضايا اجتماعية بالغة الحساسية تتصل بطبيعة المجتمع العربي في إسرائيل منها علاقة الرجل بالمرأة، وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة منذ قرون. وقد ساهمت انتماءات الكثير من الشعراء والكتاب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي في الخوض في هذه القضايا بنظرة نقدية واضحة وجريئة.
وقد رأى النقاد في خوض هؤلاء الأدباء في هذه القضايا إلى جانب الهم الوطني والقومي العام اكتمالاً ونضوجاً في الرؤية، ليس بسبب الهوية السياسية والفكرية للكاتب، بل لأن تسليط الضوء على هذه القضايا يكشف في الوقت نفسه مساعي المؤسسة الصهيونية لتكريس كل ما هو سلبي في المجتمع العربي، لتسهيل عملية تشويه الأجيال الفلسطينية الناشئة عبر «إبهارها» بنمط الحياة الغربي الذي جاء به المستوطنون من أوروبا وسواها. ويرى النقاد في الاهتمام السياسي والاجتماعي لدى الأدباء الفلسطينيين تكاملاً ضرورياً في مواجهة السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
■ يتناول الشاعر راشد حسين في قصيدته «الجياد» مسألة مفاخرة الأسر التقليدية بالمولود الذكر، واعتبار مجرد قدومه مآثرة ترفع رأس أهله، فيقول:
في قرانا بين طيات الدخان
(..) جيل أطفال كبار، كالجياد ملأت أذهانهم أشباح تفكير رمادي
مهمتهم ان تلد الزوجة مولودا ذكر
ليقولوا : إنها بنت أصيل مفتخر
وضعت طفلاً ذكر
وجهه وجه القمر
ليقولوا: زوجها فحل عظيم
رجل..
بعد هذا، ليصير ابنهم راعي ذباب.
■ وينتقد محمود درويش بأسى عسف التقاليد التي تسمح بتعرض المرأة للعنف طالما على يد أولياء أمرها، فيقول في إحدى قصائده:
وتنام أجفان الحياة
إلا بكاء من كئيب موجع
ينسل من أعماق بيت
من بيوت القرية
هي بنت شيخ القرية
تبكي وتصرخ باكتئاب
والسوط محمر الإهاب.
■ جاءت مجزرة كفر قاسم- 29/10/1956، لتفجر النقمة والغضب في صدور الفلسطينيين، وربط الشعراء والأدباء الفلسطينيين بينها وبين ما وقع من مجازر في العام 1948 على يد العصابات الصهيونية، وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، فتناول ما جرى فيها بالتوازي مع ما وقع خلال العدوان الثلاثي على مصر، الذي بدأ في يوم ارتكاب مجزرة كفر قاسم، ومع ما يجري في الجزائر في مواجهة الاحتلال الفرنسي. فيقول توفيق زياد في قصيدته «حديث الملاحم»، التي نظمها بعد أسابيع قليلة على المجزرة:
دمي هو ذاك الذي قد سفك
دمي هو ذاك وذاك دمك
وقد شربوا منه حتى ارتووا
فيا ويلهم
عندما يطلع الصبح
مما أتووا ...!!
(..) ففي مصر نحرق جيش الطغاة
ونغرقه في مياه القناة
وفي كل شبر بأرض الجزائر
تدور بأعداء شعبي الدوائر(..)
■ وللشاعر حنا أبو حنا قصيدة طويلة عن كفر قاسم، يدعوا فيها إلى وحدة الصف في وجه القتلة، جاء فيها:
كيف العزاء؟ و كيف يسلو الويل شعب ثاكل؟
عصفت بروحه الخطوب وصارعته نوازل
ما زال يحمل جرحه في صدره.. ويطاول
وتسير في الدماء، على خطاه، غوائل
إن السبيل إلى العزاء تكاتف وتكافل
ونداء أرواح الضحايا: فليهب الغافل!
ونعى حبيب قهوجي شهداء كفر قاسم واضعاً القتلة في خانة المغول والنازيين، قائلاً :
جنكيز خان تثاءبت أيامه ؟
أم جند هتلر للدمار ضواري ؟
■ وتكررت الصيغة نفسها، في قصيدة أخرى، لراشد حسين بعنوان «الغلة الحمراء»، يرثي فيها شهداء قرية صندلة، التي استشهد فيها 15 طفلًا جراء انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال ـــ 17/9/1957.
مرج ابن عامر، هل لديك سنابل
أم فيك من زرع الحروب قنابل ؟
أم حينما عز النبات صنعت من
لحم الطفولة غلة تتمايل ؟
■ ويقول محمود درويش في قصيدته «أزهار الدم»:
دمك المهدور ما زال وما زلنا نقاوم
علّمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي
وأمشي
ثمّ أمشي
وأقاوم■
(7)
مساهمات أولية في المسرح والقصة القصيرة
■ برز في تلك الفترة الكاتب توفيق فياض، وقد لفت الأنظار بأسلوبه الأدبي الخاص، وله مسرحية بعنوان «بيت الجنون»، وهي «مونودراما » من فصلين ـ حيفا، مطبعة الاتحاد ـ 1965، رأى النقاد فيها علامة بارزة في مسار المسرح الفلسطيني في أراضي الـ48. بطلها، مدرس تاريخ مطرود من عمله، يعيش في غرفته الصغيرة كابوساً مروعاً، يرى فيه أنه محاصر من قبل أشخاص جاءوا ليقبضوا عليه بلا سبب. ويعاني بطل المسرحية اختلاطاً في دواخله تجاه ما حوله يأخذ طابع الهذيان والجنون. ولكنه يخرج من هذه الحالة حين يقرر المواجهة، ويعلن يصوت عالٍ:« هناك.. أنت.. هل تسمع؟ انني لا أخافكم، لا أرهبكم، سأتحداكم جميعاً، سأنتصر عليكم جميعاً.. جميعاً، وحدي». ويتضح في نهاية العمل أنه يتوجه بتحديه .. نحوهم، أي الذين اغتصبوا حقوقه ومازالوا يسعون للتخلص منه.
وللكاتب فياض قصة بعنوان«لن يجف النبع» ــ 1961، يعرض فيها لثنائية الحياة والموت، والعلاقة الجدلية بينهما، كما جسدها بطل القصة سالم راعي الأغنام، الذي يضحى بنفسه في سبيل المجموع. كما كتب فياض رواية بعنوان «المشوهون» ــ حيفا ، مطبعة الاتحاد ــ 1964، أثارت جدلاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية والثقافية الفلسطينية.
■ وشهدت تلك الفترة إنتاجا قصصياً يُلحظ فيه لجوء الكتاب إلى الرمزية في تناول موضوع القصة، ولا يعود الأمر إلى دواعٍ فنية بحتة فقط، بل إلى سطوة الرقابة الصهيونية على ما يكتبه الفلسطينيون.
فقد كتب الشاعر فوزي الأسمر، قصة قصيرة بعنوان «رمال ودموع»، وهي ترمز إلى تمسك الفلسطيني بأرضه ومقاومة محاولات اقتلاعه، وتروي القصة وقائع محاكمة فلسطيني حاول قتل سائق جرار اسرائيلي. ويتبين خلال محاكمته أن السبب الذي دفعه لذلك هو أن السائق كان يربط جذع شجرة زيتون يملكها الفلسطيني بالجرار، محاولاً اقتلاعها. وكتب عبد الرحمن محمد سعيد قصة بعنوان «رنين الأجراس»، تنتقد العلاقات الاجتماعية من منظور طبقي. كما كتب عطا الله منصور قصة بعنوان«رياض يعود الى بيته»، تدور حول الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الفلسطيني في أراضي الـ48. ولزكي سليم درويش قصة بعنوان «نقطة دم»، تتناول مشكلات العائلة العربية الريفية، وتفشي الموروث المتخلف في العلاقات الاجتماعية. وهذه نماذج مما كتب حينها،لا يتسع المجال هنا لعرض المزيد■
(8)
ملاحظات واستخلاصات
■ يلاحظ غلبة الشعر في المشهد الثقافي الفلسطيني خلال الفترة التي يغطيها هذا الملف. وهذا طبيعي لأسباب عدة أبرزها أن هذا النوع من الأدب أكثر تجذراً ورسوخاً في الثقافة العربية عن غيره من الأنواع مثل الرواية والمسرح والقصة القصيرة حديثة العهد، والأهم مما سبق أنه نتاج فردي سهل الانتشار ولا يحتاج لأن يكون مطبوعاً كي يصل إلى الجمهور، في وقت كانت فيه المطابع والصحف والمؤسسات الثقافية تحت السيطرة المباشرة لأجهزة الحكم العسكري الإسرائيلي. وقد تغيرت هذه المعادلة إلى حد كبير في الفترات اللاحقة مع ظهور كتابات قصصية وروائية فلسطينية مهمة بعد العام 1967.
■ من الملاحظ أن الخطاب الثقافي الفلسطيني الذي نما وتبلور في أراضي الـ48 خلا من تعابير الفجيعة والندب الانكسار أمام هول كارثة النكبة التي لحقت بفلسطين وشعبها. ويعود أبرز الأسباب في ذلك طبيعة التحدي الوجودي الذي داهم الفلسطينيين في عقر دارهم، وظل ماثلاً في تفاصيل حياتهم اليومية. كان عليهم أن يخوضوا معركة البقاء والاستمرار في الحياة. وربما نلحظ ذلك في كل قصيدة نعى قائلها الشهداء، أو أطلقها شاعر من سجنه. كانت جميعها تزخر بالاعتزاز وتحدي القاتل /السجان بل وتسخر منه.
كان الشاعر والكاتب جزءاً عضوياً مما يجري ويخضع له جميع الفلسطينيين هناك، وفي مثل هذا الوضع لاوجود لـ«برج عاجي» يمارس فيه المثقف نرجسيته. فهو كغيره من الفلسطينيين من حوله: إما أن يكون في دائرة استهداف الاحتلال، أو تحت عباءته. وقد اختارت الغالبية منهم موقع المواجهة.
■ يعود نجاح المثقف الفلسطيني في أراضي الـ48، في إعادة بناء المشهد الثقافي، وإفشال محاولات تدجين الحركة الثقافة الفلسطينية الناشئة إلى كثير من الأسباب، أبرزها انخراطه المبكر في العمل السياسي من جهة، وتأثير المثقفين والكتاب المخضرمين الذي بقوا في فلسطين بعد النكبة جهة ثانية، وقد لعب هؤلاء دوراً مهماً في صيانة الجذور التي أفرعت التجربة الثقافية الفلسطينية قبل الكارثة. ولقد ساهم هذين العاملين في كسر حالة العزلة التي حاول الاحتلال إدامتها في حياة الفلسطينيين تحت حكمه. ونلحظ تأثير هذا الانعتاق النسبي في تفاعل المثقف الفلسطيني مع كل حدث كبير يدور في المحيط، ومن أدلة ذلك؛ عشرات القصائد التي أطلقها الشعراء الفلسطينيين تضامناً مع الشعوب وحركاتها السياسية التي تقارع الهيمنة الاستعمارية في مختلف أرجاء المعمورة.
■ شهدت الفترة التي يغطيها هذا الملف حضوراً قوياً لعدد من الشعراء الشباب شكلت قصائدهم علامة فارقة في الشعر الفلسطيني، أبرزهم سميح القاسم ومحمود درويش وراشد حسين، الذين شكلوا مع مبدعي الجيل الذي سبقهم وفي المقدمة الشاعر توفيق زياد، خطاباً شعرياً مميزاً في الشكل والمضمون، امتد تأثيره إلى الحركة الشعرية العربية، واحتلوا مكاناً مرموقاً في صدارة رواد الشعر العربي الحديث. وهو ما سيُلحظ على نحو أوضح في الفترة التي تلت حرب 1967، وما بعد ذلك بكثير■
15/1/2024













أضف تعليق