
إسرائيل ونحن .. والإنقسام!
هل قصد رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت الاسرائيليين أم الشعب الفلسطيني حينما قال «إن الذي يقض مضجعي هو الانقسامات الداخلية وانتشار الكراهية!» ظننت للوهلة الاولى قبل ان اتابع تفاصيل هذا الخبر العادي أن الذي يتحدث هو مسؤول فلسطيني يحذر من تداعيات الانقسام الداخلي على القضية الوطنية، قبل أن اتيقن بأن بينيت كان يتوجه إلى الإسرائيليين في تحذيره من تداعيات الانقسام داخل الكيان. وليس وحده من حذر من تداعيات هذا الانقسام، فها هو رئيس وزراء العدو الاسبق ايهود باراك يعزف على السيمفونية ذاتها بقوله: «الانقسام الداخلي يحطمنا وهو أخطر من التهديدات الخارجية، بل هو تهديد وجودي».
تتزامن هذه المواقف مع العديد من التحليلات حول تداعيات التطرف الآخذ بالازدياد داخل المجتمع الاسرائيلي، والذي يترجم بغياب وأفول ما يسمي بـ«الأحزاب والتيارات اليسارية الإسرائيلية» التي باتت بحكم المنقرضة بحيث لم يعد لها أي تأثير في الحياة السياسية الاسرائيلية، وتؤكد الانتخابات الأخيرة أن هناك تحولات داخل المجتمع تنحو باتجاهات يمينية وتطرفية عنصرية. بل أن تسابق الأحزاب الصهيونية أصبح على أصوات المستوطنين واليمين والذين باتوا يحركون دولة الكيان، في ظل تصاعد وازدياد منسوب الخوف مما هو قادم، سواء على مستوى الصراع المباشر مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، بتفصيلاته المختلفة، او لجهة تقدم المعتقدات الغيبية والاساطير التاريخية من نمط اقتراب نهاية «دولة إسرائيل» نتيجة وصولها إلى عمر افتراضي لن يزيد عن 80 عامًا..
في المقابل، يعيش المجتمع الاسرائيلي انقساماً حادًا آخذ بالاتساع عاماً بعد عام، وهو يتخذ اشكالاً مختلفة تعبر عن نفسها بعناوين «أزمة الهوية» التي عادة ما تبرز في صراعات تعتبر بالنسبة للساسة والمفكرين الاسرائيليين واحدة من المشكلات الاستراتيجية التي تعيشها اسرائيل، وهو انقسام يصل إلى درجة التناقضات احياناً بين مختلف الاثنيات والعرقيات التي يتشكل منها المجتمع اليهودي سواء بين مهاجري الغرب (الأشكناز) ومهاجري الشرق (السفارديم) من جانب، أو بين المجتمع المتدين (الحريديم) والعلمانيين من جانب ثان، أو على مستوى المهاجرين القدامى والجدد من جانب ثالث، والسكان الأصليين من العرب الفلسطينيين واليهود في جانب خاص وأخير.
لكن رغم ذلك، فهناك من يعمل على إدارة دفة هذه الانقسامات بحيث لا تشكل خطراً على الاستراتيجية العامة للحركة الصهيونية، لذلك نجد اجماعاً سياسيًا على عناوين وقضايا تشكل بالنسبة لهم «ثوابت الاجماع اليهودي» التي، مهما بلغت درجة التناقضات والخلافات، فلا يمكن لأي تيار سياسي، بل من غير المسموح لأحد ان يتجاوزها. والمواقف المعبر عنها من قبل الأحزاب الاسرائيلية في صراعها على السلطة، ليست سوى ديكورا لـ «الديمقراطية الاسرائيلية المزيفة والمخادعة» والتي تهدف لتحقيق أهداف سياسية ومكاسب على المستويين الشخصي والحزبي.
على المستوى الفلسطيني الداخلي، ورغم أن العناوين التي تجمع الشعب الفلسطيني ويفترض أن تشكل ثوابت اجماع وطني هي أكثر وضوحًا من تلك الموجودة لدى المجتمع الاسرائيلي، إلا أن الانقسام والصراع بات يتقدم على ما نعتقد انه مسلمات وطنية.. فالاهداف الوطنية العامة للشعب الفلسطيني واضحة وتحوز على دعم ليس فقط كل الشعب الفلسطيني، بل والشعوب العربية وكل احرار العالم ومدعومة بعشرات القرارات الدولية، لكن في الواقع تبدو الصورة متعاكسة لدرجة أن بعضهم بات يطرح برامج سياسية جديدة تتجاوز ما سبق وان اتفق عليه الشعب الفلسطيني وحقق على أرضيته النتائج السياسية الهامة التي اعادت للقضية الفلسطينية حضورها والقها على المستويات العربية والدولية، لكن المشكلة دائماً هي في مدى التزام القوى السياسية، خاصة الرسمية منها بعناصر هذا البرنامج..
في الترجمة العملية، ورغم أن المشروع الصهيوني بات واضحاً في استهدافه القضية الفلسطينية بأكثر من عنوان: قضايا القدس، التطبيع، مخطط الضم التدريجي، الاستيطان، قضية اللاجئين وحق العودة من مدخل وكالة الغوث وغيرها من عناوين هامة، فما زال هناك من يسعى وبشكل متعمد إلى ادامة عمر الانقسام سواء عبر تكريس وتشريع الواقع الراهن والتعاطي معه باعتباره بديهية «وطنية»، او من خلال المراهنة على مصطلح نسيناه ونساه الجميع واسمه «مفاوضات بالرعاية الامريكية»، رغم اليقين بأن الحكومات الاسرائيلية لن تجرؤ، في ظل المعطيات الراهنة، على فتح اي قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية، الا من زاوية ما يخدم مصالحها، كالتنسيق الامني مثلاً. والادارة الامريكية الحالية بدورها لا تختلف بشيء عن سابقتها إلا في بعض التكتيكات والوعود التي ما زالت مجرد عصافير على الشجرة، وهي ايضًا لن تقدم على أية خطوة تتعاكس مع المصالح الإسرائيلية..
نعود بالذاكرة الى شهر أيلول من العام 2000، حين دنس الارهابي المقبور ارئيل شارون ساحات المسجد الاقصى وكانت سبباً مباشراً لاندلاع الانتفاضة، فخرج مسؤول عربي محذرًا من أن «الدول العربية لن تبقى مكتوفة الايدي أمام ما يحصل للشعب الفلسطيني ولمدينة القدس»، وتساءلنا حينها عن النقطة التي يقصدها ذلك المسؤول كي نجد صرخة رسمية عربية «جدية»، واليوم نكرر السؤال فلسطينياً: «ما هو الاجراء الاسرائيلي الحاسم بالنسبة للفلسطينيين، منظمة وسلطة وفصائل وتيارات سياسية وشعبية مختلفة، كي نصل إلى نتيجة بأن ما يحصل يستحق ما هو أكبر من ثورة وانتفاضة. لكن رغم ذلك، فلا نجد إلا الانقسام الذي اتسع اكثر بين الكل الفلسطيني: بين اليمين واليمين، بين اليمين واليسار وبين اليسار واليسار.. لكن الصراع والانقسام هو ليس على أرضية برامج سياسية، بل على حسابات ومصالح فئوية وعلى فتات «مكاسب أوسلو» وتنفيذاً لأجندات خارجية تتقدم الى الواجهة أكثر وأكثر!
نعم لعلنا نوافق على مقولة أن الانقسام هو اكثر خطرًا على القضية الفلسطينية من صفقة القرن ومن المشاريع الاسرائيلية. ففي ظل الانقسام، انتصرنا وصمدنا في اكثر من معركة، لكننا ما زلنا عاجزين عن ترجمة واستثمار العديد من الانتصارات التي تحققت في معارك سابقة مع المحتل، سواء خلال عمليات العدوان على قطاع غزه، أو فعاليات المقاومة الشعبية في الضفة أو معارك الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها، أو التحركات الشعبية الانتفاضية في الأراضي المحتلة عام 1948.. لنصل إلى استنتاج اكدته السنوات الماضية بان لا امكانية لأي نصر أن يتجسد سياسيًا طالما بقي الانقسام وطالما أن هناك اطراف ما زالت تسعى إلى افراغ هذه الانتصارات من مضامينها، كونها تتعاكس مع مصالحها التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طبيعة المرحلة، ولا يغير من هذا الاستنتاج الاتهامات والاتهامات المتبادلة ورفع وتيرة التطرف اللفظي لدى البعض باعتبارها أسهل الخيارات الشعبوية لتحقيق مكاسب سياسية او انتخابية هنا وهناك..
قد لا يختلف اثنان على التوصيف والاستنتاج السابق، لكن الخلاف يبدأ في آلية المعالجات، وهذا ما يتطلب ضرورة استعادة بعض البديهيات الوطنية:
- إن اسرائيل هي عدو يحتل أرضنا الفلسطينية، وكل الاعراف والمواثيق الطبيعية والدولية والقانونية توجب مقاومة هذا المحتل، وهذا ما يتطلب اعادة الاعتبار لحركتنا الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني يجب ان تكون اولويتها النضال من اجل تحرير ارضها، آخذين بعين الاعتبار أهمية استمرار الصراع على العناوين المجتمعية وقضايا الحريات الديمقراطية، لإعادة صياغة بنية مؤسساتنا الوطنية ووظائفها بما يوفر مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني.
- في ظل اختلال موازين القوى، فإن قوة الشعب الفلسطيني هي في وحدة كل فئاته الاجتماعية، وهو ما يعني ضرورة اعادة الاعتبار لوحدة الشعب وتوحيده تحت راية برنامج سياسي موحد وفي إطار نظام سياسي يعتمد ويؤمن بالشراكة بين جميع المكونات الوطنية التي يجب أن تنخرط في إطار حركة التحرر الوطني، وضد التناقض الرئيسي الجامع، أي ضد الاحتلال والاستيطان.. واي صراع على السلطة من خلفية الوهم اننا تجاوزنا مرحلة التحرر الوطني فلن يقود سوى الى الهيمنة والاحتكار وإلى فساد الأجهزة والمؤسسات، وأيضاً إلى الانقسامات التي لا زالت تتوالى بنتائجها السلبية على كل تجمعات الشعب الفلسطيني.
- إن دول العالم لا تتعاطى معنا ومع قضيتنا إلا على أرضية مصالحها المباشرة، وهي لن تتخذ من المواقف السياسية ما يدعم نضالنا إلا انطلاقاً من كيفية تقديم أنفسنا وقضيتنا إلى العالم، وبعبارة أخرى فإن المواقف الدولية تتأسس على قوة وصلابة الموقف الفلسطيني.. وبالتالي فان استجداء المواقف والضغوط الدولية على اسرائيل اكدت عقود اوسلو أنها مضيعة للوقت ولن تصب إلا في مصلحة الاحتلال الذي يراكم بالنقاط مصالح وانجازات سياسية وميدانية..
امام المتغيرات الاقليمية والدولية، فليس امام الشعب الفلسطيني إلا واحد من خيارين: فإما خيار التبعية والارتهان للخارج والارتماء في الاحضان الامريكية والمساهمة في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بشكل تدريجي، بغض النظر عن حسن النوايا التي لا تقدم ولا تفيد بشيء، خاصة وأن ما هو مطروح راهنًا لا دولة ولا فتح مسار على امكانية قيام دولة، بل اقتراحات بتحسين المستوى المعيشي وتسهيل قضايا المعاملات للفلسطينيين في علاقاتهم اليومية مع سلطات الاحتلال..
والخيار الثاني هو الخيار المجرب في قطاع غزه وفي لبنان وفي القدس وجميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية، وهو خيار المقاومة المسلحة والشعبية المستند الى وحدة وطنية راسخة وشراكة حقيقية في صنع القرار وفي تحمل نتائجه. ومثل هذا الخيار لا يمكن تكريسه كثابتة من ثوابتنا الوطنية إلا حين تتقدم إلى الأمام الارادة السياسية على المواجهة وتحمل أعباء هذا الخيار الذي سيكون مكلفًا، لكن في المقابل فان تكلفة المقاومة هي أقل بكثير من تكلفة الوضع الراهن حيث الخسائر يومية على المستويات البشرية والسياسية والاقتصادية والمعنوية والنفسية.. بينما المراهنة على التغيير من الخارج فلن تنتج سوى كوارث وطنية لا زلنا نملك مفتاح تغيير مسارها باتجاهات وطنية، خاصة مع النهوض الكبير والمميز للحركة الجماهيرية الفلسطينية في فلسطين وخارجها والتي ما زالت تشكو من نقطة ضعف وحيدة تتمثل في غياب الهيئة القيادية التي تقود وتنسق وتراكم وطنيا على أي إنجاز يتحقق.
تتزامن هذه المواقف مع العديد من التحليلات حول تداعيات التطرف الآخذ بالازدياد داخل المجتمع الاسرائيلي، والذي يترجم بغياب وأفول ما يسمي بـ«الأحزاب والتيارات اليسارية الإسرائيلية» التي باتت بحكم المنقرضة بحيث لم يعد لها أي تأثير في الحياة السياسية الاسرائيلية، وتؤكد الانتخابات الأخيرة أن هناك تحولات داخل المجتمع تنحو باتجاهات يمينية وتطرفية عنصرية. بل أن تسابق الأحزاب الصهيونية أصبح على أصوات المستوطنين واليمين والذين باتوا يحركون دولة الكيان، في ظل تصاعد وازدياد منسوب الخوف مما هو قادم، سواء على مستوى الصراع المباشر مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، بتفصيلاته المختلفة، او لجهة تقدم المعتقدات الغيبية والاساطير التاريخية من نمط اقتراب نهاية «دولة إسرائيل» نتيجة وصولها إلى عمر افتراضي لن يزيد عن 80 عامًا..
في المقابل، يعيش المجتمع الاسرائيلي انقساماً حادًا آخذ بالاتساع عاماً بعد عام، وهو يتخذ اشكالاً مختلفة تعبر عن نفسها بعناوين «أزمة الهوية» التي عادة ما تبرز في صراعات تعتبر بالنسبة للساسة والمفكرين الاسرائيليين واحدة من المشكلات الاستراتيجية التي تعيشها اسرائيل، وهو انقسام يصل إلى درجة التناقضات احياناً بين مختلف الاثنيات والعرقيات التي يتشكل منها المجتمع اليهودي سواء بين مهاجري الغرب (الأشكناز) ومهاجري الشرق (السفارديم) من جانب، أو بين المجتمع المتدين (الحريديم) والعلمانيين من جانب ثان، أو على مستوى المهاجرين القدامى والجدد من جانب ثالث، والسكان الأصليين من العرب الفلسطينيين واليهود في جانب خاص وأخير.
لكن رغم ذلك، فهناك من يعمل على إدارة دفة هذه الانقسامات بحيث لا تشكل خطراً على الاستراتيجية العامة للحركة الصهيونية، لذلك نجد اجماعاً سياسيًا على عناوين وقضايا تشكل بالنسبة لهم «ثوابت الاجماع اليهودي» التي، مهما بلغت درجة التناقضات والخلافات، فلا يمكن لأي تيار سياسي، بل من غير المسموح لأحد ان يتجاوزها. والمواقف المعبر عنها من قبل الأحزاب الاسرائيلية في صراعها على السلطة، ليست سوى ديكورا لـ «الديمقراطية الاسرائيلية المزيفة والمخادعة» والتي تهدف لتحقيق أهداف سياسية ومكاسب على المستويين الشخصي والحزبي.
على المستوى الفلسطيني الداخلي، ورغم أن العناوين التي تجمع الشعب الفلسطيني ويفترض أن تشكل ثوابت اجماع وطني هي أكثر وضوحًا من تلك الموجودة لدى المجتمع الاسرائيلي، إلا أن الانقسام والصراع بات يتقدم على ما نعتقد انه مسلمات وطنية.. فالاهداف الوطنية العامة للشعب الفلسطيني واضحة وتحوز على دعم ليس فقط كل الشعب الفلسطيني، بل والشعوب العربية وكل احرار العالم ومدعومة بعشرات القرارات الدولية، لكن في الواقع تبدو الصورة متعاكسة لدرجة أن بعضهم بات يطرح برامج سياسية جديدة تتجاوز ما سبق وان اتفق عليه الشعب الفلسطيني وحقق على أرضيته النتائج السياسية الهامة التي اعادت للقضية الفلسطينية حضورها والقها على المستويات العربية والدولية، لكن المشكلة دائماً هي في مدى التزام القوى السياسية، خاصة الرسمية منها بعناصر هذا البرنامج..
في الترجمة العملية، ورغم أن المشروع الصهيوني بات واضحاً في استهدافه القضية الفلسطينية بأكثر من عنوان: قضايا القدس، التطبيع، مخطط الضم التدريجي، الاستيطان، قضية اللاجئين وحق العودة من مدخل وكالة الغوث وغيرها من عناوين هامة، فما زال هناك من يسعى وبشكل متعمد إلى ادامة عمر الانقسام سواء عبر تكريس وتشريع الواقع الراهن والتعاطي معه باعتباره بديهية «وطنية»، او من خلال المراهنة على مصطلح نسيناه ونساه الجميع واسمه «مفاوضات بالرعاية الامريكية»، رغم اليقين بأن الحكومات الاسرائيلية لن تجرؤ، في ظل المعطيات الراهنة، على فتح اي قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية، الا من زاوية ما يخدم مصالحها، كالتنسيق الامني مثلاً. والادارة الامريكية الحالية بدورها لا تختلف بشيء عن سابقتها إلا في بعض التكتيكات والوعود التي ما زالت مجرد عصافير على الشجرة، وهي ايضًا لن تقدم على أية خطوة تتعاكس مع المصالح الإسرائيلية..
نعود بالذاكرة الى شهر أيلول من العام 2000، حين دنس الارهابي المقبور ارئيل شارون ساحات المسجد الاقصى وكانت سبباً مباشراً لاندلاع الانتفاضة، فخرج مسؤول عربي محذرًا من أن «الدول العربية لن تبقى مكتوفة الايدي أمام ما يحصل للشعب الفلسطيني ولمدينة القدس»، وتساءلنا حينها عن النقطة التي يقصدها ذلك المسؤول كي نجد صرخة رسمية عربية «جدية»، واليوم نكرر السؤال فلسطينياً: «ما هو الاجراء الاسرائيلي الحاسم بالنسبة للفلسطينيين، منظمة وسلطة وفصائل وتيارات سياسية وشعبية مختلفة، كي نصل إلى نتيجة بأن ما يحصل يستحق ما هو أكبر من ثورة وانتفاضة. لكن رغم ذلك، فلا نجد إلا الانقسام الذي اتسع اكثر بين الكل الفلسطيني: بين اليمين واليمين، بين اليمين واليسار وبين اليسار واليسار.. لكن الصراع والانقسام هو ليس على أرضية برامج سياسية، بل على حسابات ومصالح فئوية وعلى فتات «مكاسب أوسلو» وتنفيذاً لأجندات خارجية تتقدم الى الواجهة أكثر وأكثر!
نعم لعلنا نوافق على مقولة أن الانقسام هو اكثر خطرًا على القضية الفلسطينية من صفقة القرن ومن المشاريع الاسرائيلية. ففي ظل الانقسام، انتصرنا وصمدنا في اكثر من معركة، لكننا ما زلنا عاجزين عن ترجمة واستثمار العديد من الانتصارات التي تحققت في معارك سابقة مع المحتل، سواء خلال عمليات العدوان على قطاع غزه، أو فعاليات المقاومة الشعبية في الضفة أو معارك الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها، أو التحركات الشعبية الانتفاضية في الأراضي المحتلة عام 1948.. لنصل إلى استنتاج اكدته السنوات الماضية بان لا امكانية لأي نصر أن يتجسد سياسيًا طالما بقي الانقسام وطالما أن هناك اطراف ما زالت تسعى إلى افراغ هذه الانتصارات من مضامينها، كونها تتعاكس مع مصالحها التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طبيعة المرحلة، ولا يغير من هذا الاستنتاج الاتهامات والاتهامات المتبادلة ورفع وتيرة التطرف اللفظي لدى البعض باعتبارها أسهل الخيارات الشعبوية لتحقيق مكاسب سياسية او انتخابية هنا وهناك..
قد لا يختلف اثنان على التوصيف والاستنتاج السابق، لكن الخلاف يبدأ في آلية المعالجات، وهذا ما يتطلب ضرورة استعادة بعض البديهيات الوطنية:
- إن اسرائيل هي عدو يحتل أرضنا الفلسطينية، وكل الاعراف والمواثيق الطبيعية والدولية والقانونية توجب مقاومة هذا المحتل، وهذا ما يتطلب اعادة الاعتبار لحركتنا الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني يجب ان تكون اولويتها النضال من اجل تحرير ارضها، آخذين بعين الاعتبار أهمية استمرار الصراع على العناوين المجتمعية وقضايا الحريات الديمقراطية، لإعادة صياغة بنية مؤسساتنا الوطنية ووظائفها بما يوفر مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني.
- في ظل اختلال موازين القوى، فإن قوة الشعب الفلسطيني هي في وحدة كل فئاته الاجتماعية، وهو ما يعني ضرورة اعادة الاعتبار لوحدة الشعب وتوحيده تحت راية برنامج سياسي موحد وفي إطار نظام سياسي يعتمد ويؤمن بالشراكة بين جميع المكونات الوطنية التي يجب أن تنخرط في إطار حركة التحرر الوطني، وضد التناقض الرئيسي الجامع، أي ضد الاحتلال والاستيطان.. واي صراع على السلطة من خلفية الوهم اننا تجاوزنا مرحلة التحرر الوطني فلن يقود سوى الى الهيمنة والاحتكار وإلى فساد الأجهزة والمؤسسات، وأيضاً إلى الانقسامات التي لا زالت تتوالى بنتائجها السلبية على كل تجمعات الشعب الفلسطيني.
- إن دول العالم لا تتعاطى معنا ومع قضيتنا إلا على أرضية مصالحها المباشرة، وهي لن تتخذ من المواقف السياسية ما يدعم نضالنا إلا انطلاقاً من كيفية تقديم أنفسنا وقضيتنا إلى العالم، وبعبارة أخرى فإن المواقف الدولية تتأسس على قوة وصلابة الموقف الفلسطيني.. وبالتالي فان استجداء المواقف والضغوط الدولية على اسرائيل اكدت عقود اوسلو أنها مضيعة للوقت ولن تصب إلا في مصلحة الاحتلال الذي يراكم بالنقاط مصالح وانجازات سياسية وميدانية..
امام المتغيرات الاقليمية والدولية، فليس امام الشعب الفلسطيني إلا واحد من خيارين: فإما خيار التبعية والارتهان للخارج والارتماء في الاحضان الامريكية والمساهمة في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بشكل تدريجي، بغض النظر عن حسن النوايا التي لا تقدم ولا تفيد بشيء، خاصة وأن ما هو مطروح راهنًا لا دولة ولا فتح مسار على امكانية قيام دولة، بل اقتراحات بتحسين المستوى المعيشي وتسهيل قضايا المعاملات للفلسطينيين في علاقاتهم اليومية مع سلطات الاحتلال..
والخيار الثاني هو الخيار المجرب في قطاع غزه وفي لبنان وفي القدس وجميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية، وهو خيار المقاومة المسلحة والشعبية المستند الى وحدة وطنية راسخة وشراكة حقيقية في صنع القرار وفي تحمل نتائجه. ومثل هذا الخيار لا يمكن تكريسه كثابتة من ثوابتنا الوطنية إلا حين تتقدم إلى الأمام الارادة السياسية على المواجهة وتحمل أعباء هذا الخيار الذي سيكون مكلفًا، لكن في المقابل فان تكلفة المقاومة هي أقل بكثير من تكلفة الوضع الراهن حيث الخسائر يومية على المستويات البشرية والسياسية والاقتصادية والمعنوية والنفسية.. بينما المراهنة على التغيير من الخارج فلن تنتج سوى كوارث وطنية لا زلنا نملك مفتاح تغيير مسارها باتجاهات وطنية، خاصة مع النهوض الكبير والمميز للحركة الجماهيرية الفلسطينية في فلسطين وخارجها والتي ما زالت تشكو من نقطة ضعف وحيدة تتمثل في غياب الهيئة القيادية التي تقود وتنسق وتراكم وطنيا على أي إنجاز يتحقق.


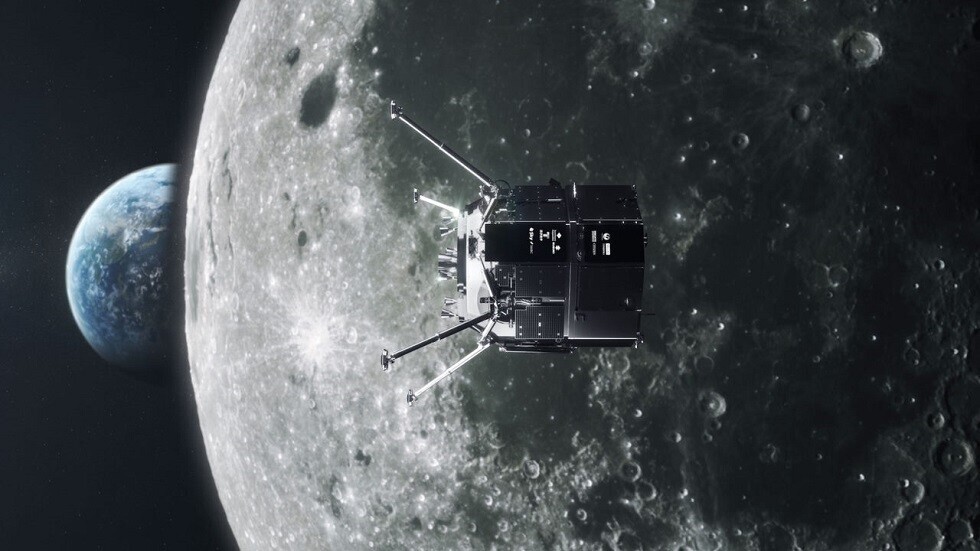




















أضف تعليق