
بأيّ حقٍ يموت الفلسطيني غرقاً؟
كأن الموت الذي يحيط بالفلسطينيين من كل جانب لا يكفي حتى يموتوا في بحار الآخرين، هرباً من موت القهر، وموت الحصار، وموت الجوع وكل أشكال الموت.
بأيّ ذنب يغامر أبناء القطاع بأرواحهم، وما هي «جريمتهم» لكي يلقوا بأنفسهم إلى أمواج البحار الهائجة على مراكب خشبية متهالكة «علّهم» يجدون في بلاد الآخرين ما يسدّ رمق أطفالهم وأمهاتهم وعائلاتهم التي لم تعد تجد في القطاع ما يبقيهم على قيد الحياة؟!
مجرد البقاء ليس أكثر.
بأي ذنبٍ يتحوّل عشرات من شبابنا إلى أشلاء في عرض البحر تمزقها الأسماك المفترسة؟
من موتٍ إلى موت يهربون، ومن أقدارٍ سوداء قاتمة إلى أقدار أكثر سواداً بطعم الفجيعة.
ماذا سيقول عن أجيالنا التاريخ؟، وكيف سيروي حكايات الموت الفلسطيني الهارب من سطوة أصحاب المصالح والأموال المنهوبة من جيوب الناس، ومن جماعات الرذيلة السياسية التي تمعن في استهبال الناس واستغفالهم وحرمانهم وقمعهم لمجرد أنهم يطالبون بحقهم بعدم الموت جوعاً.
أيّ عارٍ هذا الذي يلحق بنا جميعاً ـ ولا أستثني أحداً منّا ـ ونحن نرى شبابنا يتسابقون في طوابير من الزحام المذهل على فرصة عمل في إسرائيل، مهما كانت، ومهما بلغ أجرها، ومهما كانت مغمّسة بالمهانة والإذلال!
وكيف لنا دون أن يرفّ لنا جفن أن نطالب الناس بالصمود على الأرض، والتشبث بالوطن، والدفاع عنه في الوقت الذي يمتلك أبناء الذوات عندنا، (الذوات من كل أصناف الذوات)، الفلل والقصور والسيارات الفارهة، والحسابات البنكية في المصارف العالمية بكل أنواع العملات، وبالملايين المملينة، في حين أن يوم عمل كاملاً قد يمتد إلى ما يربو على نصف يوم كامل بما لا يزيد على ثلاثة دولارات حسب معطيات حقيقية، وليس فيها أي مبالغة أو سخرية.
إلى أين نرمي بأبناء شعبنا؟
وماذا بوسعهم أن يفعلوا بعد أن أصبحت أسرهم تتضور جوعاً وقد «أشبعناهم» شعارات وخطابات تعجز عنها كل دواوين الحماسة في الشعر العربي والأدب العربي كله؟
وهل كان «الماغوط» على خطأ ولو بحرف واحد عندما قال:
من الغباء أن أدافع عن وطن لا أملك فيه بيتاً
من الغباء أن أضحّي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي مشردين
من الغباء أن تثكل أمي بفقدي وهي لا تعرف لماذا متّ
من العار أن أترك زوجتي فريسة للكلاب من بعدي
الوطن حيث تتوفر لي مقومات الحياة، لا مسببات الموت، والانتماء كذبة اخترعها الساسة لنموت من أجلهم
لا أؤمن بالموت من أجل الوطن. الوطن لا يخسر أبداً، إنما نحن الخاسرون.
عندما يبتلى الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه. وعندما تنتهي الحرب، ينادون الأغنياء ليتقاسموا الغنائم!
عليك أن تفهم أن في وطني، تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص، وتمتلئ بطون الخونة بالأموال، ويموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة!
أعرف جيداً بوجود عدو متربص بالشعب الفلسطيني، جاثم على صدره، ينكل به، ويسرق قوته، ويستبيح أرضه، وينهب ثرواته، ويستولي على روايته وتاريخه، ويزيف الوقائع، ويقلب كل الحقائق.. وأعرف أن هذا العدو يتمنى أن يصحو في صبيحة ذات يوم وقد اختفى الشعب الفلسطيني من الوجود، وأعرف أن القهر الذي مارسه هذا العدو يفوق كل وصف وخيال.. ونعرف جيداً كلنا أن الدفاع عن الوطن مسألة لا يمكن حصرها في واقع الظلم الاجتماعي، وأن فقراء الأوطان يتسامون على جراحاتهم، ويهبون للدفاع عن أوطانهم في كل الظروف، وتاريخ شعبنا هو أسطع دليل على ذلك.. لكنْ، لكل شيء حدود، ولكل ظلم وقهر طاقة على التحمل.
عندما يؤمن الشعب، وفقراؤه على وجه الخصوص والتحديد بعدالة قضاياهم الوطنية، وعندما يقدمون أرواحهم فداءً لأوطانهم فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أوطانهم وليس لأنهم فقراء، وهم يفعلون ذلك لأنهم إن لم يفعلوا فستضيع أوطانهم، وهم لا يملكون غيرها.
متى يصبح كلام الشاعر الفذ والعبقري الساخر محمد الماغوط هو عين الحقيقة؟، ومتى يكفر الفقراء بأوطانهم؟، وطبعاً نعرف جيداً البعد المجازي الخارق في أقوال الماغوط.
الفقراء عندما لا يجدون ما يؤمنون به، وعندما تتحول قضية الوطن إلى تدليس، وعندما يعمّ الفساد الذي يركز الثروات في أيدي قلة، في حين لا يجد الفقراء كسرة الخبز، ولا يجدون من يوفر لهم العمل، ولا من يساعدهم في مرضهم ومرض أبنائهم، وعندما يقتلهم الفقر من داخلهم، وعندما يتحول العوز إلى مشهد يلازم الفقير في أدق تفاصيل حياته.
عندما يرى الفقير أن وطنه يضيع من بين يديه، وأن شعبه يفقد الثقة والأمل، وعندما يرى أصحاب المصالح والامتيازات يركبون اليخوت على الشواطئ التركية وغيرها، في حين يذهبون هم إلى حتفهم بالمراكب الخشبية المتهالكة في رحلة موت لن ينجوا منه إلا بمعجزة.
نعم الفقراء ينتظرون معجزة كي لا يموتوا غرقاً، والأغنياء هناك على الشواطئ يقهقهون «لسذاجة» هؤلاء الهاربين من الموت إلى موت آخر، ربما أكثر قسوة فقط.
وفقراء هذا الشعب، وهم الغالبية الوحيدة في بلادنا، لم يعد بإمكانهم الصبر على كل مظاهر الخلل في حياتنا.
ألم تلاحظ القيادات السياسية في بلادنا أن استجابة الناس للعمل الكفاحي باتت تخبو؟
ألم يستخلصوا العبر والدروس من تجربة المقاومة الشعبية، والتي بالرغم من سلميتها، ومن كونها درءاً لأخطار الاستيطان ومصادرة الأرض، ومن ما هي عليه من محاولة ولو بالقليل القليل لردع عربدة المستوطنين.. ألم يلاحظوا أن كل المناشدات، وكل الجهود المبذولة لا تجد عند الناس الاستجابة الكافية والضرورية؟
الشعب الفلسطيني الذي يتميز بأعلى كفاحية وطنية على وجه الأرض، والشعب الذي صنع الإعجازات والمعجزات، لم يعد مقتنعاً كما كانت عليه قناعاته المعهودة، بأننا نتحمل معاً أعباء هذا الكفاح، وبات يشك كثيراً بأن الجميع يساهمون في دفع ضريبة الدفاع عن القضية.
باختصار بات يتسرب الشك إلى فقراء هذا الوطن حول جدوى التضحية والفداء، طالما أن الذي يدفع الثمن بات يشاهد بأم عينه أن ثمة من يستحوذون على تضحياته.
ومهما كان تسامي فقراء الشعب الفلسطيني عالياً، ومهما كانت همة هذا الشعب قوية ومتجذرة فالويل لنا إذا بقينا نراهن على ذلك، أو إذا اعتقدنا أن التفويض «لنا» ما زال مفتوحاً على الزمن!
أيها السادة: المهلة بدأت بالنفاد، وغرق شباب غزة في عرض البحر ليس مجرد حادث غرق!
بأيّ ذنب يغامر أبناء القطاع بأرواحهم، وما هي «جريمتهم» لكي يلقوا بأنفسهم إلى أمواج البحار الهائجة على مراكب خشبية متهالكة «علّهم» يجدون في بلاد الآخرين ما يسدّ رمق أطفالهم وأمهاتهم وعائلاتهم التي لم تعد تجد في القطاع ما يبقيهم على قيد الحياة؟!
مجرد البقاء ليس أكثر.
بأي ذنبٍ يتحوّل عشرات من شبابنا إلى أشلاء في عرض البحر تمزقها الأسماك المفترسة؟
من موتٍ إلى موت يهربون، ومن أقدارٍ سوداء قاتمة إلى أقدار أكثر سواداً بطعم الفجيعة.
ماذا سيقول عن أجيالنا التاريخ؟، وكيف سيروي حكايات الموت الفلسطيني الهارب من سطوة أصحاب المصالح والأموال المنهوبة من جيوب الناس، ومن جماعات الرذيلة السياسية التي تمعن في استهبال الناس واستغفالهم وحرمانهم وقمعهم لمجرد أنهم يطالبون بحقهم بعدم الموت جوعاً.
أيّ عارٍ هذا الذي يلحق بنا جميعاً ـ ولا أستثني أحداً منّا ـ ونحن نرى شبابنا يتسابقون في طوابير من الزحام المذهل على فرصة عمل في إسرائيل، مهما كانت، ومهما بلغ أجرها، ومهما كانت مغمّسة بالمهانة والإذلال!
وكيف لنا دون أن يرفّ لنا جفن أن نطالب الناس بالصمود على الأرض، والتشبث بالوطن، والدفاع عنه في الوقت الذي يمتلك أبناء الذوات عندنا، (الذوات من كل أصناف الذوات)، الفلل والقصور والسيارات الفارهة، والحسابات البنكية في المصارف العالمية بكل أنواع العملات، وبالملايين المملينة، في حين أن يوم عمل كاملاً قد يمتد إلى ما يربو على نصف يوم كامل بما لا يزيد على ثلاثة دولارات حسب معطيات حقيقية، وليس فيها أي مبالغة أو سخرية.
إلى أين نرمي بأبناء شعبنا؟
وماذا بوسعهم أن يفعلوا بعد أن أصبحت أسرهم تتضور جوعاً وقد «أشبعناهم» شعارات وخطابات تعجز عنها كل دواوين الحماسة في الشعر العربي والأدب العربي كله؟
وهل كان «الماغوط» على خطأ ولو بحرف واحد عندما قال:
من الغباء أن أدافع عن وطن لا أملك فيه بيتاً
من الغباء أن أضحّي بنفسي ليعيش أطفالي من بعدي مشردين
من الغباء أن تثكل أمي بفقدي وهي لا تعرف لماذا متّ
من العار أن أترك زوجتي فريسة للكلاب من بعدي
الوطن حيث تتوفر لي مقومات الحياة، لا مسببات الموت، والانتماء كذبة اخترعها الساسة لنموت من أجلهم
لا أؤمن بالموت من أجل الوطن. الوطن لا يخسر أبداً، إنما نحن الخاسرون.
عندما يبتلى الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه. وعندما تنتهي الحرب، ينادون الأغنياء ليتقاسموا الغنائم!
عليك أن تفهم أن في وطني، تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص، وتمتلئ بطون الخونة بالأموال، ويموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة!
أعرف جيداً بوجود عدو متربص بالشعب الفلسطيني، جاثم على صدره، ينكل به، ويسرق قوته، ويستبيح أرضه، وينهب ثرواته، ويستولي على روايته وتاريخه، ويزيف الوقائع، ويقلب كل الحقائق.. وأعرف أن هذا العدو يتمنى أن يصحو في صبيحة ذات يوم وقد اختفى الشعب الفلسطيني من الوجود، وأعرف أن القهر الذي مارسه هذا العدو يفوق كل وصف وخيال.. ونعرف جيداً كلنا أن الدفاع عن الوطن مسألة لا يمكن حصرها في واقع الظلم الاجتماعي، وأن فقراء الأوطان يتسامون على جراحاتهم، ويهبون للدفاع عن أوطانهم في كل الظروف، وتاريخ شعبنا هو أسطع دليل على ذلك.. لكنْ، لكل شيء حدود، ولكل ظلم وقهر طاقة على التحمل.
عندما يؤمن الشعب، وفقراؤه على وجه الخصوص والتحديد بعدالة قضاياهم الوطنية، وعندما يقدمون أرواحهم فداءً لأوطانهم فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أوطانهم وليس لأنهم فقراء، وهم يفعلون ذلك لأنهم إن لم يفعلوا فستضيع أوطانهم، وهم لا يملكون غيرها.
متى يصبح كلام الشاعر الفذ والعبقري الساخر محمد الماغوط هو عين الحقيقة؟، ومتى يكفر الفقراء بأوطانهم؟، وطبعاً نعرف جيداً البعد المجازي الخارق في أقوال الماغوط.
الفقراء عندما لا يجدون ما يؤمنون به، وعندما تتحول قضية الوطن إلى تدليس، وعندما يعمّ الفساد الذي يركز الثروات في أيدي قلة، في حين لا يجد الفقراء كسرة الخبز، ولا يجدون من يوفر لهم العمل، ولا من يساعدهم في مرضهم ومرض أبنائهم، وعندما يقتلهم الفقر من داخلهم، وعندما يتحول العوز إلى مشهد يلازم الفقير في أدق تفاصيل حياته.
عندما يرى الفقير أن وطنه يضيع من بين يديه، وأن شعبه يفقد الثقة والأمل، وعندما يرى أصحاب المصالح والامتيازات يركبون اليخوت على الشواطئ التركية وغيرها، في حين يذهبون هم إلى حتفهم بالمراكب الخشبية المتهالكة في رحلة موت لن ينجوا منه إلا بمعجزة.
نعم الفقراء ينتظرون معجزة كي لا يموتوا غرقاً، والأغنياء هناك على الشواطئ يقهقهون «لسذاجة» هؤلاء الهاربين من الموت إلى موت آخر، ربما أكثر قسوة فقط.
وفقراء هذا الشعب، وهم الغالبية الوحيدة في بلادنا، لم يعد بإمكانهم الصبر على كل مظاهر الخلل في حياتنا.
ألم تلاحظ القيادات السياسية في بلادنا أن استجابة الناس للعمل الكفاحي باتت تخبو؟
ألم يستخلصوا العبر والدروس من تجربة المقاومة الشعبية، والتي بالرغم من سلميتها، ومن كونها درءاً لأخطار الاستيطان ومصادرة الأرض، ومن ما هي عليه من محاولة ولو بالقليل القليل لردع عربدة المستوطنين.. ألم يلاحظوا أن كل المناشدات، وكل الجهود المبذولة لا تجد عند الناس الاستجابة الكافية والضرورية؟
الشعب الفلسطيني الذي يتميز بأعلى كفاحية وطنية على وجه الأرض، والشعب الذي صنع الإعجازات والمعجزات، لم يعد مقتنعاً كما كانت عليه قناعاته المعهودة، بأننا نتحمل معاً أعباء هذا الكفاح، وبات يشك كثيراً بأن الجميع يساهمون في دفع ضريبة الدفاع عن القضية.
باختصار بات يتسرب الشك إلى فقراء هذا الوطن حول جدوى التضحية والفداء، طالما أن الذي يدفع الثمن بات يشاهد بأم عينه أن ثمة من يستحوذون على تضحياته.
ومهما كان تسامي فقراء الشعب الفلسطيني عالياً، ومهما كانت همة هذا الشعب قوية ومتجذرة فالويل لنا إذا بقينا نراهن على ذلك، أو إذا اعتقدنا أن التفويض «لنا» ما زال مفتوحاً على الزمن!
أيها السادة: المهلة بدأت بالنفاد، وغرق شباب غزة في عرض البحر ليس مجرد حادث غرق!

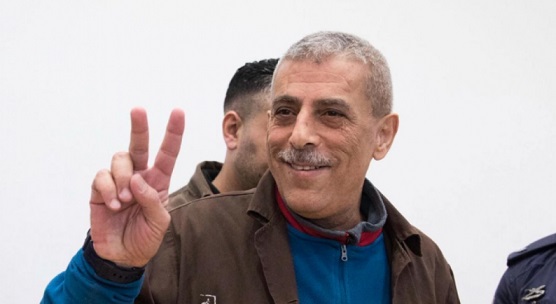













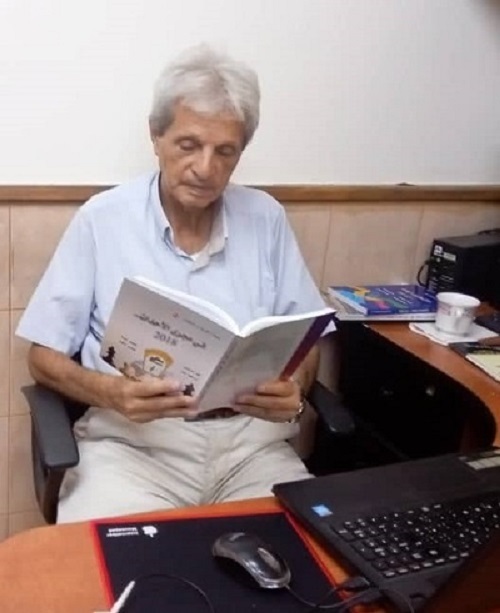



أضف تعليق