
«أمن إسرائيل» هو الشق الثالث من صفقة ترامب
• ورشة البحرين كرست التحالف الأمني السياسي بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية بشكل معلن وصريح
• كل خطوة تحالفية عربية إسرائيلية بذريعة الخطر الإيراني، تقوم على حساب القضية الفلسطينية
• مشروع ترامب نتنياهو يعتمد فرض «الحقائق الميدانية» بديلاً «لحقائق» الشرعية الدولية، و«حقائق» التاريخ
• الشق الثالث والأمني لصفقة ترامب يستند إلى «مبادئ نتنياهو الستة»
• لماذا سارت صفقة ترامب قدماً على الصعيد الإقليمي دون عراقيل تلجم إندفاعتها؟
(1)
■ حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته حل قضية «الصراع في المنطقة»، بإطلاق صفقة سياسية كاملة للحل، على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، أطلق بعض الرؤساء العرب، كما أطلق بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين على هذه الصفقة اسم « صفقة القرن» أو «صفقة العصر».
لم يكن ترامب هو من أطلق على صفقته هذا الإسم، ولم يكن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الإحتلال. من أطلق عليها هذا الإسم، هم الذين استماتوا من أجل الإسراع في الكشف عنها، والذين استماتوا كي تكون خشبة الإنقاذ للعملية التفاوضية، المعطلة بقرار من حكومة إسرائيل منذ العام 2014، حين رفضت كل العروض التي كانت في جعبة وزير خارجية إدارة أوباما، جون كيري.
اللقاءات الفلسطينية مع ترامب، حملت للفلسطينيين بشارة بأنه متفهم للقضية الفلسطينية، وبأنه مع «حل الدولتين» بما يضمن قيام دولة فلسطينية في إطار تطبيقات «الحل الدائم» لإتفاق أوسلو؛ وأن صفقته ستكون حقاً صفقة العصر، لأنها ستضع نهاية لصراع مديد صار عمره أكثر من سبعين عاماً (على فرض أنه ابتدأ مع النكبة وليس مع الإستعمار البريطاني لفلسطين).
لم يقرأوا السياسة الأميركية الجديدة. لم يقرأوا إستراتيجيات ترامب في أنحاء مختلفة من العالم. لم يقرأوا فيه ملامح «الرجل الأبيض» صاحب المشاريع الإستعمارية، ورجل إحياء النزعات الإمبريالية بأبشع صورها. إلى أن كانت «الصفعة». دوت في أزقة القدس القديمة على وجه المراهنين على ترامب. كما تركت بصماتها الواضحة والجلية على سياستهم، فأوقعت في يدهم. ولم يجدوا وسيلة لرد «الصفعة»، سوى الشكوى، وسوى الرفض اللفظي والكلامي ذي النبرة العالية، ليغطوا حالة العجز السياسي عن القيام ولو بخطوة عملية واحدة، تعيد الكرامة إلى من أساءت «الصفعة» لكرامتهم .
(2)
■ بدأت «الصفقة» تسير على مسارين متوازيين. دون الكشف عن مضمونها.
مسار فلسطيني – إسرائيلي، في فرض الوقائع الميدانية بإجراءات أحادية تستند إلى «الحقائق» القائمة، وليس إلى «حقائق التاريخ» أو حقائق «الشرعية الدولية» أو «حقائق القانون الدولي».
من هنا صارت القدس عاصمة لإسرائيل، كجزء من «الحقيقة» التي تحاول إدارة ترامب وحكومة نتنياهو فرضها على الجميع.
وأصبح الاستيطان حقيقة هو الآخر. ووجود المستوطنين في أنحاء الضفة «حقيقة» أخرى واللجوء بات «حقيقة» أما وكالة الغوث فهي خارج الحقيقة ويجب إزالتها. وكذلك باتت خارج الحقيقة قرارات الشرعية الدولية، بحيث أصبح بقاء الجولان السوري المحتل تحت السيطرة الإسرائيلية جزءاً من الحقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لمزارع شبعا، وتلال كفر شوبا في جنوب لبنان. وفي تطبيق سياسة فرض الحقائق الميدانية باعتبارها هي الحل، أخذ الاستيطان يتوسع بشكل جنوني، وبدأت طبول الحرب تدق هنا وهناك. كل ذلك تمهيداً للإعلان عن المضمون السياسي «لصفقة ترامب، نتنياهو»، أي الإعلان عن المولود، الذي ولد على دفعات، وبات اسمه مكشوفاً، وعلاماته معروفة للجميع. ولم يبق سوى الاحتفال بالولادة، ليس إلا. فالولادة سجلت على أنها في 6/12/2017، حين وقع ترامب قرار إدارته الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وحين قرر نقل سفارة بلاده إليها.■
(3)
■ أما على المسار الإقليمي، فالخطوات لم تكن أقل خطراً. بل شكلت الوجه الآخر للخطر الأميركي – الإسرائيلي.
نجحت «الصفقة» في إعادة رسم معادلة «الصراع» في المنطقة. وهذا من أخطر ما توصلت إليه، وما حققته عملياً. إذ لم تعد إسرائيل ومشروعها التوسعي، هي الخطر الداهم على المصالح العربية. شطبت «الصفقة» تاريخاً من الصراع والعدوان الإسرائيلي الدموي ضد العرب، بشحطة قلم. أزاحته جانباً، ولم تشطب ولم تلغِ أسبابه وجذوره.
جذور الصراع والعدوان هو المشروع الإسرائيلي التوسعي في المنطقة. ودور أمني – عسكري تلعبه دولة الاحتلال في خدمة المشروع الأميركي، لمنع المنطقة من أن تتحرر من القيود الإمبريالية الأميركية والغربية.
ضربت المشروع الناصري في مصر. وجرت أكبر دولة عربية نحو حل منفرد مع إسرائيل وأخرجتها من الصراع. وجعلت منها «وسيطاً» بعدما كانت قائدة للمشروع القومي ضد المشروع الصهيوني.
ضربت المشروع النهضوي في العراق حين دمرت مفاعل تموز النووي، لقطع الطريق على بناء عراق جديد، يرتقي في قوته الاقتصادية والعسكرية إلى مستويات متقدمة.
تعتدي على سوريا، حتى في خضم انشغالها في أزمتها الداخلية، لتعطل عليها الخروج نحو مرحلة جديدة.
اعتدت على تونس، بأكثر من أسلوب، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليات الاغتيال الجاسوسية، والإنزالات البحرية.
اعتدت على لبنان واحتلت أجزاء مهمة من جنوبه، وعبثت بأوضاعه الداخلية وغذت نيران حروبه الأهلية.
مازالت تحتل أجزاء من الأردن، وتهدد مستقبله باعتباره «الوطن البديل» للفلسطينيين.
اعتدت على ليبيا، وعلى السودان، في إطار المشروع الأميركي لفرض إصطفافات إقليمية ذات نسق سياسي معين.
مازالت تبني طموحاتها الاقتصادية وفقاً لمشروع «الشرق الأوسط الجديد»، بحيث لا تكتفي بإقامة «إسرائيل الكبرى» عبر ضم أوسع للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية إليها، بل وفرض الهيمنة الأمنية، والاقتصادية على المنطقة باعتبارها الطرف الإقليمي الأقوى، بقواه الذاتية، وبالدعم الأميركي غير المحدود.
(4)
■ الوجه الآخر للمعادلة الجديدة، هو اعتبار «إيران»، هي الخطر، وهي العدو للحالة العربية. ما يجمع الأنظمة العربية، وإسرائيل والولايات المتحدة في خندق واحد (حلف إقليمي) ضد إيران، وفي السياق، ضد سوريا، وضد حلفاء إيران، كحزب الله وغيره من الأحزاب العربية، كما في العراق مثلاً.
الحلف الإقليمي، يفترض دفع القضية الفلسطينية إلى الخلف، وتقديم الصراع مع إيران إلى الأمام.
وهذا يفترض، واقعياَ، وعملياً، اعتماد التقاطعات ونقاط الالتقاء الأمنية والعسكرية والسياسية الإقليمية مع دولة الاحتلال. والانفتاح عليها، والتقارب معها.
وكل تقارب مع إسرائيل هو ابتعاد عن فلسطين والقضية الفلسطينية.
وكل خطوة نحو إسرائيل، بذريعة مجابهة ما يسمى الخطر الإيراني، هي خطوة بعيداً عن فلسطين.
لا تكفي البيانات التي مازالت تلتزم «مبادرة السلام العربية» وآليات تطبيقها.
ولا تكفي البيانات التي مازالت تؤكد الالتزام القومي بالقضية الفلسطينية.
ولا تكفي البيانات التي مازالت تؤكد على حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية والقدس عاصمتها، على حدود 4 حزيران.
معظم هذا الكلام على جاذبيته، فقد مضمونه. وتحول إلى إعلانات لفظية لا تدعم القضية الفلسطينية إلا ببعض المبالغ المالية وهو الشكل الأضعف بل الأكثر ضعفاً من الإيمان بالقضية الفلسطينية، خاصة لمن لديهم فائض أسطوري من المال.
استقبال نتنياهو في مسقط، والوفود الإسرائيلية في الدوحة، وفي أبو ظبي وفي المنامة، لا يكون إلا على حساب القضية الفلسطينية. يعزز قوة دولة الاحتلال. ويضعف القضية الفلسطينية.
الحديث عن أن القضية الفلسطينية لم تزل هي القضية المركزية لدى الأنظمة العربية، الموالية للسياسات الأميركية، خرافة، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة ... «الخطر الإيراني» المزعوم هو القضية المركزية. والانخراط في الحرب الاقتصادية والدعاوية والأمنية ضد إيران، بات هو الواجب الأول في الالتزامات الإقليمية، وهناك تبنى الخطوات العملية، أما الكلام المجاني لفلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين .
(5)
■ بعد الحديث المطول عن قرب الكشف عن «المضمون السياسي» لصفقة ترامب – نتنياهو، وقع التفاف استراتيجي ودراماتيكي كبير، حين تم الإعلان عن تأجيل هذه الخطوة لصالح خطوة بديلة، بعقد ورشة في البحرين، تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار»، باعتبارها «الشق الاقتصادي» للصفقة. وباعتراف كوشنير، وغرينبلات، عرابي صفقة «ترامب – نتنياهو» فإن الصفقة باتت الآن ذات شقين اثنين، هما الشق السياسي، الذي ما زالت الولايات المتحدة تروج للإعلان عنه، بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة إسرائيلية جديد في أيلول (سبتمبر) القادم، والشق الاقتصادي الذي قدم له كوشنير في ورشة البحرين خطة من أربعين صفحة. تقوم على سلسلة مشاريع خرافية، للحالة الفلسطينية، ولدول عربية أخرى، كلبنان، ومصر، والأردن، (وفي قلب هؤلاء جميعاً إسرائيل) كلفتها لا تقل عن خمسين مليار دولار، ستؤمن الدول العربية الغنية الجزء الأكبر منها.
من أهم تداعيات ورشة البحرين، أن أطرافاً عربية باتت شركاء في صفقة «ترامب- نتنياهو»، بشكل معلن، ودون أي خجل أو مواربة. وأن العلاقات الإسرائيلية مع بعض العواصم العربية باتت رسمية ومعلنة ولا داعي لإخفائها والتستر عليها. هذا يشكل بداية لمسار جديد في العلاقات العربية الإسرائيلية سيكون له خط تصاعدي، وعلى الدوام، على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
أميركا وإسرائيل، وعواصم عربية شركاء في «صفقة ترامب–نتنياهو»، بذريعة التحالف ضد إيران. هذا التحالف سيكون ثمنه باهظاً ومكلفاً جداً من حسابات القضية الفلسطينية.
(6)
■ الشق الثالث من «الصفقة» هو مالم يتم الإعلان عنه رسمياً. أعلن عنه نتنياهو في «مبادئه الستة». والتي تقوم على اعتبار الضفة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل. وأن حدود إسرائيل هي نهر الأردن، وأن لا دولة ثالثة بين الأردن وإسرائيل، وأن السيطرة الإسرائيلية ستكون كاملة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى شواطئ غزة، في البر، والبحر، والجو. وأن المستوطنات جزء من إسرائيل. وأنه لا اقتلاع لمستوطن واحد مقابل اقتلاع مئات الفلسطينيين من منازلهم في القدس، وخان الأحمر، وصور باهر، وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية.
كل هذه الإجراءات الاستيطانية، مبررها، في حسابات نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، دواعي أمنية، الذريعة الدائمة التي تضعها دولة الاحتلال في مقدمة تبريرها لأعمالها العدوانية.
اعتداءاتها على دول الجوار ضربات استباقية لحماية أمن إسرائيل.
حصارها على القطاع إجراء أمني.
تدمير حي وادي الحمص في صور باهر، تدبير أمني.
ضم الضفة الفلسطينية وصولاً إلى بلدة «كريمة» الأردنية تدبير أمني.
الإمساك بالمعابر البرية والبحرية والجوية لأي «كيان» فلسطيني قادم هو تدبير أمني.
وهكذا، تجتمع العناصر الثلاثة لصفقة «ترامب – نتنياهو»، السياسي والاقتصادي والأمني، لتشكل أساساً سياسياً أيديولوجياً، لإقامة دولة إسرائيل الكبرى.
في الوقت نفسه، مازالت الحالة العربية الرسمية تنزاح نحو اعتبار إسرائيل حليفاً في تحالف ترعاه الولايات المتحدة ضد الخطر المزعوم الآتي من طهران.
• كل خطوة تحالفية عربية إسرائيلية بذريعة الخطر الإيراني، تقوم على حساب القضية الفلسطينية
• مشروع ترامب نتنياهو يعتمد فرض «الحقائق الميدانية» بديلاً «لحقائق» الشرعية الدولية، و«حقائق» التاريخ
• الشق الثالث والأمني لصفقة ترامب يستند إلى «مبادئ نتنياهو الستة»
• لماذا سارت صفقة ترامب قدماً على الصعيد الإقليمي دون عراقيل تلجم إندفاعتها؟
(1)
■ حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته حل قضية «الصراع في المنطقة»، بإطلاق صفقة سياسية كاملة للحل، على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، أطلق بعض الرؤساء العرب، كما أطلق بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين على هذه الصفقة اسم « صفقة القرن» أو «صفقة العصر».
لم يكن ترامب هو من أطلق على صفقته هذا الإسم، ولم يكن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الإحتلال. من أطلق عليها هذا الإسم، هم الذين استماتوا من أجل الإسراع في الكشف عنها، والذين استماتوا كي تكون خشبة الإنقاذ للعملية التفاوضية، المعطلة بقرار من حكومة إسرائيل منذ العام 2014، حين رفضت كل العروض التي كانت في جعبة وزير خارجية إدارة أوباما، جون كيري.
اللقاءات الفلسطينية مع ترامب، حملت للفلسطينيين بشارة بأنه متفهم للقضية الفلسطينية، وبأنه مع «حل الدولتين» بما يضمن قيام دولة فلسطينية في إطار تطبيقات «الحل الدائم» لإتفاق أوسلو؛ وأن صفقته ستكون حقاً صفقة العصر، لأنها ستضع نهاية لصراع مديد صار عمره أكثر من سبعين عاماً (على فرض أنه ابتدأ مع النكبة وليس مع الإستعمار البريطاني لفلسطين).
لم يقرأوا السياسة الأميركية الجديدة. لم يقرأوا إستراتيجيات ترامب في أنحاء مختلفة من العالم. لم يقرأوا فيه ملامح «الرجل الأبيض» صاحب المشاريع الإستعمارية، ورجل إحياء النزعات الإمبريالية بأبشع صورها. إلى أن كانت «الصفعة». دوت في أزقة القدس القديمة على وجه المراهنين على ترامب. كما تركت بصماتها الواضحة والجلية على سياستهم، فأوقعت في يدهم. ولم يجدوا وسيلة لرد «الصفعة»، سوى الشكوى، وسوى الرفض اللفظي والكلامي ذي النبرة العالية، ليغطوا حالة العجز السياسي عن القيام ولو بخطوة عملية واحدة، تعيد الكرامة إلى من أساءت «الصفعة» لكرامتهم .
(2)
■ بدأت «الصفقة» تسير على مسارين متوازيين. دون الكشف عن مضمونها.
مسار فلسطيني – إسرائيلي، في فرض الوقائع الميدانية بإجراءات أحادية تستند إلى «الحقائق» القائمة، وليس إلى «حقائق التاريخ» أو حقائق «الشرعية الدولية» أو «حقائق القانون الدولي».
من هنا صارت القدس عاصمة لإسرائيل، كجزء من «الحقيقة» التي تحاول إدارة ترامب وحكومة نتنياهو فرضها على الجميع.
وأصبح الاستيطان حقيقة هو الآخر. ووجود المستوطنين في أنحاء الضفة «حقيقة» أخرى واللجوء بات «حقيقة» أما وكالة الغوث فهي خارج الحقيقة ويجب إزالتها. وكذلك باتت خارج الحقيقة قرارات الشرعية الدولية، بحيث أصبح بقاء الجولان السوري المحتل تحت السيطرة الإسرائيلية جزءاً من الحقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لمزارع شبعا، وتلال كفر شوبا في جنوب لبنان. وفي تطبيق سياسة فرض الحقائق الميدانية باعتبارها هي الحل، أخذ الاستيطان يتوسع بشكل جنوني، وبدأت طبول الحرب تدق هنا وهناك. كل ذلك تمهيداً للإعلان عن المضمون السياسي «لصفقة ترامب، نتنياهو»، أي الإعلان عن المولود، الذي ولد على دفعات، وبات اسمه مكشوفاً، وعلاماته معروفة للجميع. ولم يبق سوى الاحتفال بالولادة، ليس إلا. فالولادة سجلت على أنها في 6/12/2017، حين وقع ترامب قرار إدارته الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وحين قرر نقل سفارة بلاده إليها.■
(3)
■ أما على المسار الإقليمي، فالخطوات لم تكن أقل خطراً. بل شكلت الوجه الآخر للخطر الأميركي – الإسرائيلي.
نجحت «الصفقة» في إعادة رسم معادلة «الصراع» في المنطقة. وهذا من أخطر ما توصلت إليه، وما حققته عملياً. إذ لم تعد إسرائيل ومشروعها التوسعي، هي الخطر الداهم على المصالح العربية. شطبت «الصفقة» تاريخاً من الصراع والعدوان الإسرائيلي الدموي ضد العرب، بشحطة قلم. أزاحته جانباً، ولم تشطب ولم تلغِ أسبابه وجذوره.
جذور الصراع والعدوان هو المشروع الإسرائيلي التوسعي في المنطقة. ودور أمني – عسكري تلعبه دولة الاحتلال في خدمة المشروع الأميركي، لمنع المنطقة من أن تتحرر من القيود الإمبريالية الأميركية والغربية.
ضربت المشروع الناصري في مصر. وجرت أكبر دولة عربية نحو حل منفرد مع إسرائيل وأخرجتها من الصراع. وجعلت منها «وسيطاً» بعدما كانت قائدة للمشروع القومي ضد المشروع الصهيوني.
ضربت المشروع النهضوي في العراق حين دمرت مفاعل تموز النووي، لقطع الطريق على بناء عراق جديد، يرتقي في قوته الاقتصادية والعسكرية إلى مستويات متقدمة.
تعتدي على سوريا، حتى في خضم انشغالها في أزمتها الداخلية، لتعطل عليها الخروج نحو مرحلة جديدة.
اعتدت على تونس، بأكثر من أسلوب، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليات الاغتيال الجاسوسية، والإنزالات البحرية.
اعتدت على لبنان واحتلت أجزاء مهمة من جنوبه، وعبثت بأوضاعه الداخلية وغذت نيران حروبه الأهلية.
مازالت تحتل أجزاء من الأردن، وتهدد مستقبله باعتباره «الوطن البديل» للفلسطينيين.
اعتدت على ليبيا، وعلى السودان، في إطار المشروع الأميركي لفرض إصطفافات إقليمية ذات نسق سياسي معين.
مازالت تبني طموحاتها الاقتصادية وفقاً لمشروع «الشرق الأوسط الجديد»، بحيث لا تكتفي بإقامة «إسرائيل الكبرى» عبر ضم أوسع للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية إليها، بل وفرض الهيمنة الأمنية، والاقتصادية على المنطقة باعتبارها الطرف الإقليمي الأقوى، بقواه الذاتية، وبالدعم الأميركي غير المحدود.
(4)
■ الوجه الآخر للمعادلة الجديدة، هو اعتبار «إيران»، هي الخطر، وهي العدو للحالة العربية. ما يجمع الأنظمة العربية، وإسرائيل والولايات المتحدة في خندق واحد (حلف إقليمي) ضد إيران، وفي السياق، ضد سوريا، وضد حلفاء إيران، كحزب الله وغيره من الأحزاب العربية، كما في العراق مثلاً.
الحلف الإقليمي، يفترض دفع القضية الفلسطينية إلى الخلف، وتقديم الصراع مع إيران إلى الأمام.
وهذا يفترض، واقعياَ، وعملياً، اعتماد التقاطعات ونقاط الالتقاء الأمنية والعسكرية والسياسية الإقليمية مع دولة الاحتلال. والانفتاح عليها، والتقارب معها.
وكل تقارب مع إسرائيل هو ابتعاد عن فلسطين والقضية الفلسطينية.
وكل خطوة نحو إسرائيل، بذريعة مجابهة ما يسمى الخطر الإيراني، هي خطوة بعيداً عن فلسطين.
لا تكفي البيانات التي مازالت تلتزم «مبادرة السلام العربية» وآليات تطبيقها.
ولا تكفي البيانات التي مازالت تؤكد الالتزام القومي بالقضية الفلسطينية.
ولا تكفي البيانات التي مازالت تؤكد على حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية والقدس عاصمتها، على حدود 4 حزيران.
معظم هذا الكلام على جاذبيته، فقد مضمونه. وتحول إلى إعلانات لفظية لا تدعم القضية الفلسطينية إلا ببعض المبالغ المالية وهو الشكل الأضعف بل الأكثر ضعفاً من الإيمان بالقضية الفلسطينية، خاصة لمن لديهم فائض أسطوري من المال.
استقبال نتنياهو في مسقط، والوفود الإسرائيلية في الدوحة، وفي أبو ظبي وفي المنامة، لا يكون إلا على حساب القضية الفلسطينية. يعزز قوة دولة الاحتلال. ويضعف القضية الفلسطينية.
الحديث عن أن القضية الفلسطينية لم تزل هي القضية المركزية لدى الأنظمة العربية، الموالية للسياسات الأميركية، خرافة، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة ... «الخطر الإيراني» المزعوم هو القضية المركزية. والانخراط في الحرب الاقتصادية والدعاوية والأمنية ضد إيران، بات هو الواجب الأول في الالتزامات الإقليمية، وهناك تبنى الخطوات العملية، أما الكلام المجاني لفلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين .
(5)
■ بعد الحديث المطول عن قرب الكشف عن «المضمون السياسي» لصفقة ترامب – نتنياهو، وقع التفاف استراتيجي ودراماتيكي كبير، حين تم الإعلان عن تأجيل هذه الخطوة لصالح خطوة بديلة، بعقد ورشة في البحرين، تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار»، باعتبارها «الشق الاقتصادي» للصفقة. وباعتراف كوشنير، وغرينبلات، عرابي صفقة «ترامب – نتنياهو» فإن الصفقة باتت الآن ذات شقين اثنين، هما الشق السياسي، الذي ما زالت الولايات المتحدة تروج للإعلان عنه، بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة إسرائيلية جديد في أيلول (سبتمبر) القادم، والشق الاقتصادي الذي قدم له كوشنير في ورشة البحرين خطة من أربعين صفحة. تقوم على سلسلة مشاريع خرافية، للحالة الفلسطينية، ولدول عربية أخرى، كلبنان، ومصر، والأردن، (وفي قلب هؤلاء جميعاً إسرائيل) كلفتها لا تقل عن خمسين مليار دولار، ستؤمن الدول العربية الغنية الجزء الأكبر منها.
من أهم تداعيات ورشة البحرين، أن أطرافاً عربية باتت شركاء في صفقة «ترامب- نتنياهو»، بشكل معلن، ودون أي خجل أو مواربة. وأن العلاقات الإسرائيلية مع بعض العواصم العربية باتت رسمية ومعلنة ولا داعي لإخفائها والتستر عليها. هذا يشكل بداية لمسار جديد في العلاقات العربية الإسرائيلية سيكون له خط تصاعدي، وعلى الدوام، على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
أميركا وإسرائيل، وعواصم عربية شركاء في «صفقة ترامب–نتنياهو»، بذريعة التحالف ضد إيران. هذا التحالف سيكون ثمنه باهظاً ومكلفاً جداً من حسابات القضية الفلسطينية.
(6)
■ الشق الثالث من «الصفقة» هو مالم يتم الإعلان عنه رسمياً. أعلن عنه نتنياهو في «مبادئه الستة». والتي تقوم على اعتبار الضفة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل. وأن حدود إسرائيل هي نهر الأردن، وأن لا دولة ثالثة بين الأردن وإسرائيل، وأن السيطرة الإسرائيلية ستكون كاملة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى شواطئ غزة، في البر، والبحر، والجو. وأن المستوطنات جزء من إسرائيل. وأنه لا اقتلاع لمستوطن واحد مقابل اقتلاع مئات الفلسطينيين من منازلهم في القدس، وخان الأحمر، وصور باهر، وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية.
كل هذه الإجراءات الاستيطانية، مبررها، في حسابات نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، دواعي أمنية، الذريعة الدائمة التي تضعها دولة الاحتلال في مقدمة تبريرها لأعمالها العدوانية.
اعتداءاتها على دول الجوار ضربات استباقية لحماية أمن إسرائيل.
حصارها على القطاع إجراء أمني.
تدمير حي وادي الحمص في صور باهر، تدبير أمني.
ضم الضفة الفلسطينية وصولاً إلى بلدة «كريمة» الأردنية تدبير أمني.
الإمساك بالمعابر البرية والبحرية والجوية لأي «كيان» فلسطيني قادم هو تدبير أمني.
وهكذا، تجتمع العناصر الثلاثة لصفقة «ترامب – نتنياهو»، السياسي والاقتصادي والأمني، لتشكل أساساً سياسياً أيديولوجياً، لإقامة دولة إسرائيل الكبرى.
في الوقت نفسه، مازالت الحالة العربية الرسمية تنزاح نحو اعتبار إسرائيل حليفاً في تحالف ترعاه الولايات المتحدة ضد الخطر المزعوم الآتي من طهران.








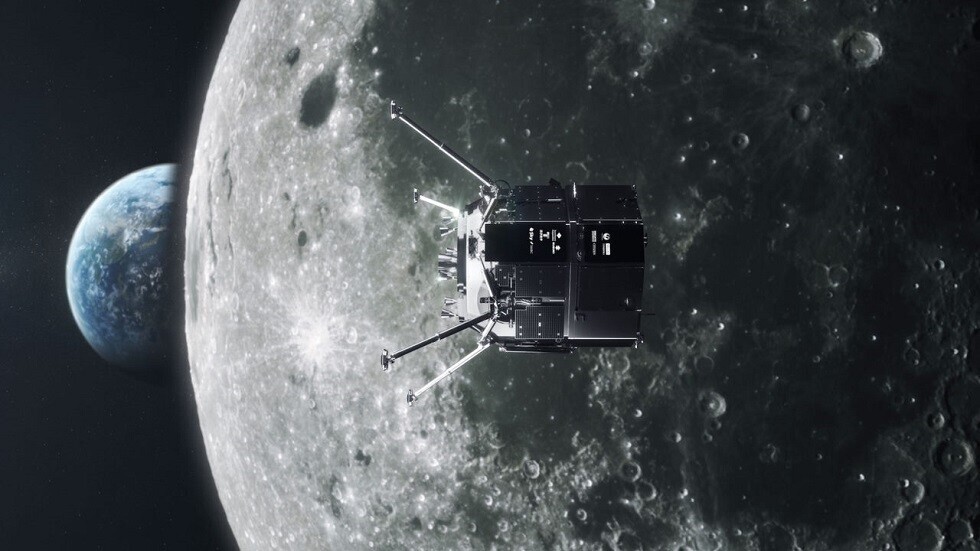














أضف تعليق