
السلام والأمن في العلاقات الدولية
الاتجاه الديمقراطي(وكالات)
السلام والأمن هما ظاهرة قديمة ومتجددة في الوقت نفسه كانا ولا يزالان مطلباً وضرورة إنسانية لتخليص البشرية من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات والعنف والإرهاب.
الأمن، السلام، النزاع ... مصطلحات أصبحت محور اهتمام مختلف الفواعل الدولية، ومحل نقاش من طرف العديد من الباحثين والأوساط الأكاديمية باعتبارها من أبرز المواضيع البحثية في حقل الدراسات الأمنية. ويُقارب كتاب مقدمة في دراسات السلام والأمن في نظرية العلاقات الدولية ، الصادر عن دار روافد الثقافية-ناشرون ودار النديم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى (2017) مساهمة في مقاربة مفاهيم السلام والأمن كضرورة استراتيجية في مواجهة قاعدة العنف والصراع والحرب.
وقد حاول المؤلف في مجال الدراسات الأمنية، مقاربة الحقل الأمني من خلال المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكمن أهمية الكتاب في تنامي الاهتمام بالظاهرة الأمنية في الوقت الحالي نظراً لما تشهده البشرية من تزايد ملحوظ ومهول في معدلات النزاعات والصراعات وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب. ولتوضيح ذلك فقد أطر المؤلف موضوع الكتاب في فصيلن وكل فصل عبارة عن مجموعة من المحاور.
يقدم الفصل الأول (نظرية السلام في العلاقات الدولية)؛ سياقات وتحولات دراسات السلام التي أصبحت من أبرز المحاور التي حظيت باهتمام الدول والبناءات الوظيفية الدولية الرسمية وغير الرسمية وكذا مراكز الفكر والمدارس والجامعات المتخصصة في أبحاث السلام والأمن، وذلك بهدف العمل على تحقيق السلم العالمي. وقد تناولت النقطة الأولى من هذا الفصل الإطار المفاهيمي والتعريفي للسلام، هذا المفهوم الذي سطع نوره مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتي كانت من أهم نتائجها بروز قطبين ومعسكرين الأول غربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والثاني شرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي. كما ظهرت من الناحية الأكاديمية مجموعة من الأبحاث والدراسات والمشاريع التي تعنى بدراسة أسباب الحرب والصراع. أما من الناحية العملية والواقعية فقد تميزت بتأسيس الأمم المتحدة التي تعد من أهم المشاريع الدولية التي وسمت القرن العشرين من أجل تحقيق السلم والأمن بين الشعوب والأمم.
وقد تنامى الاهتمام بدراسات ظواهر السلام بتدرج المراحل التي مرت منها الحياة الدولية، ولتوسع أبعاده من خلال انتقاله من السلبية إلى الإيجابية ورقعته من خلال عدم انحصاره في السلام المحلي وانتقاله إلى السلام العالمي، وتنوع مواضيعه بحيث لم تعد محصورة في معالجة قضايا النزاعات والحروب والصراعات بل أصبحت تشمل أيضا مجالات البيئة وحقوق الإنسان والتنمية بشكل كلي.
وقد ارتبط الجهاز المفاهيمي للسلام وتوسع نطاقه بظهور العديد من المدارس والمؤسسات ومراكز الفكر والأكاديميات المتخصصة في دراسات السلام أبزرها: معهد أوسلو لأبحاث السلام، جامعة برادفورد لدراسات السلام، جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة. هذه البنيات الأكاديمية والعلمية التي وضعت مجموعة من الأهداف التي يسعى مجال دراسات السلام تحقيقها وهي تشخيص الأسباب والدوافع الكامنة وراء تزايد نسبة وحدة حالات العنف والنزاع في العالم من أجل تحديد الآليات الممكن استخدامها للوقاية من هذه الظواهر السلبية وتوظيف وسائل التعاون لحل النزاعات بالطرق السلمية من أجل تحقيق السلام الاجتماعي.
وقد تنوعت استخدامات مفهوم السلام من طرف الباحثين والمتهمين في مجال السلام، فهناك من استعمل مفهوم السلام الدائم الذي تمحور حول ضمان السلام المستمر في النظام الدولي. وهناك من اتبع مفهوم السلام المستقر وهو عبارة سلام حذر وتعاون محدود نتيجة اختلاف القيم والأهداف، بالإضافة إلى اتجاه منظوره إلى السلام غير المستقر وهو ما يعرف بالسلام السلبي إذ على الرغم من غياب العنف تبقى حدة التوتر والشك قائمة. ثم هناك السلام العادل الذي يؤكد على أهمية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل إقرار وصنع وحفظ وبناء السلام. وأخيراً هناك السلام الديمقراطي الذي يقر بمبادئ الديمقراطية من أجل نشر السلام على الرغم من عدم واقعية هذا المفهوم.
وقد عالجت مجموعة من الإسهامات الفكرية المداخل السائدة في مجال السلام والنزاع من خلال مقاربة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية والتي تقوم على فرضية أساسية بأن عدم إشباع هذه الاحتياجات والمتطلبات هو مصدر النزاع والعنف القائم بين الجماعات البشرية، ومقاربة الجندر والتي تقوم على نظرية أساسية وهي أن السبيل لتحقيق السلم والتعاون وإحقاق العدالة هو ضمان إشراك النساء في بناء السلام نظراً لدورهم الفعال في صنع السلام، وأيضاً مقاربة التعلم الاجتماعي التي تعتمد في معالجة الظاهرة من خلال الاعتماد على نظريات علم النفس وعلم الاجتماع والتي تساهم بشكل كبير ومهم في درء مخاطر تزايد الظواهر العدوانية التي تولّد النزاعات.
كما أبرز المؤلف دور التربية من أجل تعزيز السلام وبلورة ثقافته، بحيث كان لمجهود مجموعة من الفواعل الدولية ومنها المنظمات الدولية وأبرزها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو دور مهم في إحقاق مبدأ التعاون والتوافق والتفاهم الإنساني والتضامن بين الحضارات كسبيل لتقوية ثقافة السلام والحوار ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك عبر تطوير التعليم الاجتماعي باعتباره بعداً أساسياً من أبعاد التنمية القائم على المعرفة والمهارات والقيم التي شكّلت محور تربية السلام وإنعاش لثقافته.
وقد تولد عن تطوير منظومة السلام ظهور مجموعة من الآليات لإحقاقه على أرض الواقع، وقد شكّلت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى أبرز هذه الآليات، وذلك عبر مساهمتها في التدخل في النزاعات المسلحة الدولية من أجل المساهمة في تسويتها أو وقفها، وبحفظ السلم والأمن الدوليين اللذين يعتبران من المبادئ الرئيسية التي أنشئت على إثرها منظمة الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فلقوات حفظ السلام بجانب مهامها العسكرية مهام أخرى شبه عسكرية وأعمال مدنية من أجل تأمين الأمن والسلام ومساعدة البلدان التي تنتشر فيها الصراعات والنزاعات والحروب، وذلك عبر العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام ونشر الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والعمل على تحقيق ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات. وتتشابه قوات حفظ السلام مع بعض القوات الدولية الأخرى من قبيل قوات نظام الأمن الجماعي والأحلاف العسكرية والقوات المتعددة الجنسيات.
وقد عالج المؤلف في نقطة أخرى، إشكالية تطبيق القوة لتحقيق السلام في النزاعات المسلحة من المنظور الأممي، بحيث أكد أن تطبيق القوة المادية بنوعيها العسكري أو غير العسكري عبر مجموعة من الوسائل كمراقبة وقف النار أو نزع الأسلحة أو تحقيق مصالحة وطنية وغيرها، كفيلة في تسوية أي نزاع داخلي، ولكن ذلك يبقى مرهوناً بشرط عدم المساس بسيادة الدول وعدم الانزياح عن الأهداف والاختصاصات المحددة وفق القوانين الدولية.
الفصل الثاني وعنوانه (الأمن بين تناقض المفهوم واختلاف المنظور)؛ يرى الكاتب أن التصورات والطروحات حول المنظور الأمني تتعدد باعتبار أن القضايا الأمنية هي من أبرز التحديات التي تهدد المجتمع الدولي. ويعتبر الأمن بمفهومه الواسع هو السعي لتحقيق الاستقلال السياسي للدول وسلامة أراضيها وضمان الاسقرار السياسي والاجتماعي الداخلي ودفع المخاطر والتهديدات بمختلف أبعادها.
وفي هذا الصدد، فقد شمل المفهوم الواسع للأمن مجموعة من الأبعاد الكبرى من أهمها، البعد السياسي الذي يعتبر العنصر الأساسي للحفاظ على كيان الدولة وضمان اسقرارها، وذلك عبر تحديد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها من أجل التغلب على المعيقات والتحديات وتحقيق المصالح. والبعد الاجتماعي الذي يعتبر مركزية الدراسات الأمنية إذ يعتبر عنصراً مهماً في عملية الاستقرار الاجتماعي من خلال تحقيق التمازج الاجتماعي والثقافي داخل المجتمعات وتنمية روح التعايش.
أضف إلى ذلك البعد الاقتصادي الذي يسهر على توفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الأفراد والمجتمعات وتوفير الآليات المناسبة لازدهارها وتقدمها. كما يعتبر البعد العسكري الاستراتيجي من أكثر أبعاد الأمن فاعلية وعنصراً مهماً في تأكيد قوة الدولة ومكانتها في النظام الدولي. كما يرتبط هذا البعد بالأبعاد الأمنية الأخرى ارتباطاً متداخلاً بحيث أن اختلال أو ضعف أي منهما يؤثر لا محالة على القوة العسكرية والقدرة الاسترايجية للدولة.
أما البعد البيئي الذي يعد من الأبعاد المستحدثة في المنظور الأمني فتجلى في تحقيق الأمن ضد الأخطار البيئية عن طريق رسم سياسات عامة بيئية من أجل المحافظة على المنظومة الإيكولوجية العالمية.
ولم يقتصر المنظور الأمني في طروحاته وتصوراته على الأبعاد السالفة الذكر فقط، بل تعداها ليشمل نظريات أخرى تتمحور مواضيعها حول مستويات الأمن، هذه المستويات التي تعددت أنواعها، بين الأمن الوطني أو ما يسمى أيضاً بأمن الدولة الذي يسعى إلى حماية القيم الداخلية من التهديدات الخارجية وإلى الحفاظ على كيان الدولة وحقها في البقاء من خلال الاعتماد على مجموعة من الأسس الاقتصادية والتنموية والحضارية وغيرها.
وهناك الأمن المجتمعي الذي يرتكز على الهوية باعتبارها ركيزة لتثبيت قيم المجتمع ونمط عيشه. والأمن الإنساني الذي يسعى إلى حماية حقوق وحريات الأفراد من كل التهديدات السياسية والاقتصادية والاجماعية.
أما الأمن الإقليمي أو ما يسمى كذلك بالأمن الجهوي فهو عبارة عن ترابط مجموعة من الدول تحت غطاء قاري كالأمن الأوروبي ويسعى إلى الدفاع عن الوحدات المشكلة للإقليم من خلال تأسيس نظام أمني إقليمي متكامل. وأخيراً الأمن الدولي الذي يعني حماية المجموعة الدولية من الأخطار والتهديدات التي تمس استقرار النظام الدولي، ولمواجهة هذه الأخطار تتولى العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة مهمة الحفاظ على الأمن الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن تعدد أبعاد ومستويات الأمن لازمه في نفس الوقت بروز مجموعة من التنظيرات الأمنية في العلاقات الدولية، ومن أبرزها، النظرية الواقعية بنوعيها التقليدي والتجديدي التي استندت إلى مجموعة من المرتكزات في تحليلها الأمني ومن أهمها اعتبار الدولة الفاعل الأساسي والعقلاني التي في مقدورها إحقاق قدر ممكن من الأمن باستنادها إلى الدبلوماسية والقوة العسكرية باعتبارهما سبيلاً لتحقيق المصلحة العليا والقومية للدولة، بالإضافة إلى استنادها إلى منظور ميزان القوى باعتباره العامل الأساسي لاستقرار النظام الدولي في ظل استمرارية التوتر والحروب والتنافس داخل الحياة الدولية.
وفي هذا السياق، برزت أيضاً النظرية الليبرالية والتي جاءت كأطروحة بديلة عن التصورات التي قدمتها المدرسة الواقعية من خلال وضعها لمجموعة من الرؤى التي تساعد على فهم المقاربات الأمنية، بحيث اعتمد الليبراليون علىى مفهومي الأمن الجماعي والسلام الديمقراطي لوضع تصوراتهم، هذه التصورات التي تمركزت حول تقليص حدة النزاعات بين الدول عن طريق تكريس مفهوم التعاون ونشر قيم الديمقراطية وثقافة الانفتاح والتداخل بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الوسائل الأساسية للحفاظ على السلام بين الدول.
في المقابل، ظهرت مجموعة من الاتجاهات الحديثة للأمن، برزت من خلالها مجموعة من التيارات والتنظيرات، كالنظرية البنائية التي ظهرت في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وانطلقت أفكارها باعتبار الفواعل في العلاقات الدولية ليست دول فقط بل حتى المنظمات الدولية بالإضافة إلى الفواعل غير الوطنية. وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال إقرارها بدور الحركات الوطنية، مع ارتكازها إلى عنصر الهوية باعتبارها مسألة جوهرية خصوصاً مع ظهور قضايا الأقليات وتحول الصراعات بين الدول إلى صراعات داخل الدول وتحول الصراع الأيديولوجي العرقي إلى صراع حضاري فكري ثفافي.
كما ظهرت النقدية كمنظور أمني بعد الحرب الباردة، إذ حاولت فهم واقع الدول من جهة ومحاولة تغييره من جهة أخرى. وقد اعتبرت النقدية اتجاهاً أو مدرسة شملت مجموعة من العلوم في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال مدرسة فرانكفورت التي قدمت مشروعاً حداثياً باسم العقلانية، بحيث اعتبرت انسجام الأفراد داخل المجتمعات من خلال تنظيم الفاعلات بين الأفراد والدول هو السبيل لتحقيق أمن تشاركي.
وإلى جانب مدرسة فرانكفورت ظهرت مدرسة كوبنهاغن التي أسست نظريتها باستنادها على مفهومي الأمن المجتمعي والأمننة، إذ عملت على مقاربة الأمن ومعالجته من منظور حديث، باعتباره بناءً اجتماعياً يتشكل عبر الممارسة وبشكل ديناميكي، متجاوزة بذلك المنظور التقليدي الذي يرتكز إلى الحروب بين الدول، كما أنها أعادت الاعتبار للمجتمع وقضاياه.
ولقد أثار الكتاب في نقطة أخرى قضية الأمن الإنساني كاستراتيجية شاملة والعودة لمحورية الفرد، إذ يعتبر أن تحقيق الأمن القومي رهين بتحقيق الأمن الإنساني، باعتبار الأخير يمثل النقطة المركزية لتحرر الإنسانية من المعاناة النابعة من الكوارث التي صنعها الإنسان على جميع المستويات سواء محلية أو إقليمية أو دولية. فالأمن الإنساني يضع مجموعة من الأهداف التي ترتكز إلى الأفراد والتنمية من أجل صون كرامة الإنسان وتلبية حاجاته المادية والمعنوية، وتحقيق الأمن عن طريق اتباع سياسات تنموية حكيمة ورشيدة في كل المجالات.
وقد خصص المؤلف آخر محور في هذا الكتاب لتوضيح التصور الأمني لمرحلة ما بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر 2001، إذ يعتبر هذا الحدث تحولاً حاسماً في تاريخ العلاقات الدولية من خلال ما أنتجه من تغييرات بنيوية في النظام الدولي، برز من خلاله التصور الأميركي للأمن الذي تبني استراتيجية هجومية استباقية ووقائية لدرء المخاطر والقضاء على التهديدات الأمنية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وذلك كردة فعل على أحداث 11 أيلول – سبتمبر. وكانت نتيجة هذا التصور خوض سلسلة من الحروب في أفغانستان والعراق والتي كان نتاجها كوارث إنسانية وبيئية لا حصر لها.
وقد تعزز منظور التهديدات الأمنية الجديدة من خلال تجاوز مفاهيم الأمن التقليدية، من خلال التركيز على الأمن الجماعي وإعادة رسم الخريطة الأمنية العالمية وتبني استراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية بتصوراتها القديمة والجديدة خصوصاً مع الانتشار الواسع لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيث أن التهديدات الأمنية الجديدة لا تعترف بالحدود الوطنية.
لذلك يعتبر الأمن الجماعي بحسب المؤلف هو التصور الأمني الأبرز لمواجهة التحديات والتهديدات والأخطار الأمنية لما بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر.
ويخلص المؤلف إلى أن السلام والأمن باعتبارهما ظاهرة قديمة ومتجددة في نفس الوقت، كانا ولا يزالان مطلباً وضرورة إنسانية لتخليص البشرية من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات والعنف والإرهاب.
ومن صفوة القول، إنه كتاب مهم يستحق المتابعة، يؤسس للتأثيرات المتباينة لمنظورات السلام والأمن، باعتبارهما مركز ثقل في استقرار حياة الدولة.
الأمن، السلام، النزاع ... مصطلحات أصبحت محور اهتمام مختلف الفواعل الدولية، ومحل نقاش من طرف العديد من الباحثين والأوساط الأكاديمية باعتبارها من أبرز المواضيع البحثية في حقل الدراسات الأمنية. ويُقارب كتاب مقدمة في دراسات السلام والأمن في نظرية العلاقات الدولية ، الصادر عن دار روافد الثقافية-ناشرون ودار النديم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى (2017) مساهمة في مقاربة مفاهيم السلام والأمن كضرورة استراتيجية في مواجهة قاعدة العنف والصراع والحرب.
وقد حاول المؤلف في مجال الدراسات الأمنية، مقاربة الحقل الأمني من خلال المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكمن أهمية الكتاب في تنامي الاهتمام بالظاهرة الأمنية في الوقت الحالي نظراً لما تشهده البشرية من تزايد ملحوظ ومهول في معدلات النزاعات والصراعات وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب. ولتوضيح ذلك فقد أطر المؤلف موضوع الكتاب في فصيلن وكل فصل عبارة عن مجموعة من المحاور.
يقدم الفصل الأول (نظرية السلام في العلاقات الدولية)؛ سياقات وتحولات دراسات السلام التي أصبحت من أبرز المحاور التي حظيت باهتمام الدول والبناءات الوظيفية الدولية الرسمية وغير الرسمية وكذا مراكز الفكر والمدارس والجامعات المتخصصة في أبحاث السلام والأمن، وذلك بهدف العمل على تحقيق السلم العالمي. وقد تناولت النقطة الأولى من هذا الفصل الإطار المفاهيمي والتعريفي للسلام، هذا المفهوم الذي سطع نوره مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتي كانت من أهم نتائجها بروز قطبين ومعسكرين الأول غربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والثاني شرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي. كما ظهرت من الناحية الأكاديمية مجموعة من الأبحاث والدراسات والمشاريع التي تعنى بدراسة أسباب الحرب والصراع. أما من الناحية العملية والواقعية فقد تميزت بتأسيس الأمم المتحدة التي تعد من أهم المشاريع الدولية التي وسمت القرن العشرين من أجل تحقيق السلم والأمن بين الشعوب والأمم.
وقد تنامى الاهتمام بدراسات ظواهر السلام بتدرج المراحل التي مرت منها الحياة الدولية، ولتوسع أبعاده من خلال انتقاله من السلبية إلى الإيجابية ورقعته من خلال عدم انحصاره في السلام المحلي وانتقاله إلى السلام العالمي، وتنوع مواضيعه بحيث لم تعد محصورة في معالجة قضايا النزاعات والحروب والصراعات بل أصبحت تشمل أيضا مجالات البيئة وحقوق الإنسان والتنمية بشكل كلي.
وقد ارتبط الجهاز المفاهيمي للسلام وتوسع نطاقه بظهور العديد من المدارس والمؤسسات ومراكز الفكر والأكاديميات المتخصصة في دراسات السلام أبزرها: معهد أوسلو لأبحاث السلام، جامعة برادفورد لدراسات السلام، جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة. هذه البنيات الأكاديمية والعلمية التي وضعت مجموعة من الأهداف التي يسعى مجال دراسات السلام تحقيقها وهي تشخيص الأسباب والدوافع الكامنة وراء تزايد نسبة وحدة حالات العنف والنزاع في العالم من أجل تحديد الآليات الممكن استخدامها للوقاية من هذه الظواهر السلبية وتوظيف وسائل التعاون لحل النزاعات بالطرق السلمية من أجل تحقيق السلام الاجتماعي.
وقد تنوعت استخدامات مفهوم السلام من طرف الباحثين والمتهمين في مجال السلام، فهناك من استعمل مفهوم السلام الدائم الذي تمحور حول ضمان السلام المستمر في النظام الدولي. وهناك من اتبع مفهوم السلام المستقر وهو عبارة سلام حذر وتعاون محدود نتيجة اختلاف القيم والأهداف، بالإضافة إلى اتجاه منظوره إلى السلام غير المستقر وهو ما يعرف بالسلام السلبي إذ على الرغم من غياب العنف تبقى حدة التوتر والشك قائمة. ثم هناك السلام العادل الذي يؤكد على أهمية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل إقرار وصنع وحفظ وبناء السلام. وأخيراً هناك السلام الديمقراطي الذي يقر بمبادئ الديمقراطية من أجل نشر السلام على الرغم من عدم واقعية هذا المفهوم.
وقد عالجت مجموعة من الإسهامات الفكرية المداخل السائدة في مجال السلام والنزاع من خلال مقاربة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية والتي تقوم على فرضية أساسية بأن عدم إشباع هذه الاحتياجات والمتطلبات هو مصدر النزاع والعنف القائم بين الجماعات البشرية، ومقاربة الجندر والتي تقوم على نظرية أساسية وهي أن السبيل لتحقيق السلم والتعاون وإحقاق العدالة هو ضمان إشراك النساء في بناء السلام نظراً لدورهم الفعال في صنع السلام، وأيضاً مقاربة التعلم الاجتماعي التي تعتمد في معالجة الظاهرة من خلال الاعتماد على نظريات علم النفس وعلم الاجتماع والتي تساهم بشكل كبير ومهم في درء مخاطر تزايد الظواهر العدوانية التي تولّد النزاعات.
كما أبرز المؤلف دور التربية من أجل تعزيز السلام وبلورة ثقافته، بحيث كان لمجهود مجموعة من الفواعل الدولية ومنها المنظمات الدولية وأبرزها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو دور مهم في إحقاق مبدأ التعاون والتوافق والتفاهم الإنساني والتضامن بين الحضارات كسبيل لتقوية ثقافة السلام والحوار ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك عبر تطوير التعليم الاجتماعي باعتباره بعداً أساسياً من أبعاد التنمية القائم على المعرفة والمهارات والقيم التي شكّلت محور تربية السلام وإنعاش لثقافته.
وقد تولد عن تطوير منظومة السلام ظهور مجموعة من الآليات لإحقاقه على أرض الواقع، وقد شكّلت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى أبرز هذه الآليات، وذلك عبر مساهمتها في التدخل في النزاعات المسلحة الدولية من أجل المساهمة في تسويتها أو وقفها، وبحفظ السلم والأمن الدوليين اللذين يعتبران من المبادئ الرئيسية التي أنشئت على إثرها منظمة الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فلقوات حفظ السلام بجانب مهامها العسكرية مهام أخرى شبه عسكرية وأعمال مدنية من أجل تأمين الأمن والسلام ومساعدة البلدان التي تنتشر فيها الصراعات والنزاعات والحروب، وذلك عبر العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام ونشر الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والعمل على تحقيق ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات. وتتشابه قوات حفظ السلام مع بعض القوات الدولية الأخرى من قبيل قوات نظام الأمن الجماعي والأحلاف العسكرية والقوات المتعددة الجنسيات.
وقد عالج المؤلف في نقطة أخرى، إشكالية تطبيق القوة لتحقيق السلام في النزاعات المسلحة من المنظور الأممي، بحيث أكد أن تطبيق القوة المادية بنوعيها العسكري أو غير العسكري عبر مجموعة من الوسائل كمراقبة وقف النار أو نزع الأسلحة أو تحقيق مصالحة وطنية وغيرها، كفيلة في تسوية أي نزاع داخلي، ولكن ذلك يبقى مرهوناً بشرط عدم المساس بسيادة الدول وعدم الانزياح عن الأهداف والاختصاصات المحددة وفق القوانين الدولية.
الفصل الثاني وعنوانه (الأمن بين تناقض المفهوم واختلاف المنظور)؛ يرى الكاتب أن التصورات والطروحات حول المنظور الأمني تتعدد باعتبار أن القضايا الأمنية هي من أبرز التحديات التي تهدد المجتمع الدولي. ويعتبر الأمن بمفهومه الواسع هو السعي لتحقيق الاستقلال السياسي للدول وسلامة أراضيها وضمان الاسقرار السياسي والاجتماعي الداخلي ودفع المخاطر والتهديدات بمختلف أبعادها.
وفي هذا الصدد، فقد شمل المفهوم الواسع للأمن مجموعة من الأبعاد الكبرى من أهمها، البعد السياسي الذي يعتبر العنصر الأساسي للحفاظ على كيان الدولة وضمان اسقرارها، وذلك عبر تحديد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها من أجل التغلب على المعيقات والتحديات وتحقيق المصالح. والبعد الاجتماعي الذي يعتبر مركزية الدراسات الأمنية إذ يعتبر عنصراً مهماً في عملية الاستقرار الاجتماعي من خلال تحقيق التمازج الاجتماعي والثقافي داخل المجتمعات وتنمية روح التعايش.
أضف إلى ذلك البعد الاقتصادي الذي يسهر على توفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الأفراد والمجتمعات وتوفير الآليات المناسبة لازدهارها وتقدمها. كما يعتبر البعد العسكري الاستراتيجي من أكثر أبعاد الأمن فاعلية وعنصراً مهماً في تأكيد قوة الدولة ومكانتها في النظام الدولي. كما يرتبط هذا البعد بالأبعاد الأمنية الأخرى ارتباطاً متداخلاً بحيث أن اختلال أو ضعف أي منهما يؤثر لا محالة على القوة العسكرية والقدرة الاسترايجية للدولة.
أما البعد البيئي الذي يعد من الأبعاد المستحدثة في المنظور الأمني فتجلى في تحقيق الأمن ضد الأخطار البيئية عن طريق رسم سياسات عامة بيئية من أجل المحافظة على المنظومة الإيكولوجية العالمية.
ولم يقتصر المنظور الأمني في طروحاته وتصوراته على الأبعاد السالفة الذكر فقط، بل تعداها ليشمل نظريات أخرى تتمحور مواضيعها حول مستويات الأمن، هذه المستويات التي تعددت أنواعها، بين الأمن الوطني أو ما يسمى أيضاً بأمن الدولة الذي يسعى إلى حماية القيم الداخلية من التهديدات الخارجية وإلى الحفاظ على كيان الدولة وحقها في البقاء من خلال الاعتماد على مجموعة من الأسس الاقتصادية والتنموية والحضارية وغيرها.
وهناك الأمن المجتمعي الذي يرتكز على الهوية باعتبارها ركيزة لتثبيت قيم المجتمع ونمط عيشه. والأمن الإنساني الذي يسعى إلى حماية حقوق وحريات الأفراد من كل التهديدات السياسية والاقتصادية والاجماعية.
أما الأمن الإقليمي أو ما يسمى كذلك بالأمن الجهوي فهو عبارة عن ترابط مجموعة من الدول تحت غطاء قاري كالأمن الأوروبي ويسعى إلى الدفاع عن الوحدات المشكلة للإقليم من خلال تأسيس نظام أمني إقليمي متكامل. وأخيراً الأمن الدولي الذي يعني حماية المجموعة الدولية من الأخطار والتهديدات التي تمس استقرار النظام الدولي، ولمواجهة هذه الأخطار تتولى العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة مهمة الحفاظ على الأمن الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن تعدد أبعاد ومستويات الأمن لازمه في نفس الوقت بروز مجموعة من التنظيرات الأمنية في العلاقات الدولية، ومن أبرزها، النظرية الواقعية بنوعيها التقليدي والتجديدي التي استندت إلى مجموعة من المرتكزات في تحليلها الأمني ومن أهمها اعتبار الدولة الفاعل الأساسي والعقلاني التي في مقدورها إحقاق قدر ممكن من الأمن باستنادها إلى الدبلوماسية والقوة العسكرية باعتبارهما سبيلاً لتحقيق المصلحة العليا والقومية للدولة، بالإضافة إلى استنادها إلى منظور ميزان القوى باعتباره العامل الأساسي لاستقرار النظام الدولي في ظل استمرارية التوتر والحروب والتنافس داخل الحياة الدولية.
وفي هذا السياق، برزت أيضاً النظرية الليبرالية والتي جاءت كأطروحة بديلة عن التصورات التي قدمتها المدرسة الواقعية من خلال وضعها لمجموعة من الرؤى التي تساعد على فهم المقاربات الأمنية، بحيث اعتمد الليبراليون علىى مفهومي الأمن الجماعي والسلام الديمقراطي لوضع تصوراتهم، هذه التصورات التي تمركزت حول تقليص حدة النزاعات بين الدول عن طريق تكريس مفهوم التعاون ونشر قيم الديمقراطية وثقافة الانفتاح والتداخل بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الوسائل الأساسية للحفاظ على السلام بين الدول.
في المقابل، ظهرت مجموعة من الاتجاهات الحديثة للأمن، برزت من خلالها مجموعة من التيارات والتنظيرات، كالنظرية البنائية التي ظهرت في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وانطلقت أفكارها باعتبار الفواعل في العلاقات الدولية ليست دول فقط بل حتى المنظمات الدولية بالإضافة إلى الفواعل غير الوطنية. وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال إقرارها بدور الحركات الوطنية، مع ارتكازها إلى عنصر الهوية باعتبارها مسألة جوهرية خصوصاً مع ظهور قضايا الأقليات وتحول الصراعات بين الدول إلى صراعات داخل الدول وتحول الصراع الأيديولوجي العرقي إلى صراع حضاري فكري ثفافي.
كما ظهرت النقدية كمنظور أمني بعد الحرب الباردة، إذ حاولت فهم واقع الدول من جهة ومحاولة تغييره من جهة أخرى. وقد اعتبرت النقدية اتجاهاً أو مدرسة شملت مجموعة من العلوم في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال مدرسة فرانكفورت التي قدمت مشروعاً حداثياً باسم العقلانية، بحيث اعتبرت انسجام الأفراد داخل المجتمعات من خلال تنظيم الفاعلات بين الأفراد والدول هو السبيل لتحقيق أمن تشاركي.
وإلى جانب مدرسة فرانكفورت ظهرت مدرسة كوبنهاغن التي أسست نظريتها باستنادها على مفهومي الأمن المجتمعي والأمننة، إذ عملت على مقاربة الأمن ومعالجته من منظور حديث، باعتباره بناءً اجتماعياً يتشكل عبر الممارسة وبشكل ديناميكي، متجاوزة بذلك المنظور التقليدي الذي يرتكز إلى الحروب بين الدول، كما أنها أعادت الاعتبار للمجتمع وقضاياه.
ولقد أثار الكتاب في نقطة أخرى قضية الأمن الإنساني كاستراتيجية شاملة والعودة لمحورية الفرد، إذ يعتبر أن تحقيق الأمن القومي رهين بتحقيق الأمن الإنساني، باعتبار الأخير يمثل النقطة المركزية لتحرر الإنسانية من المعاناة النابعة من الكوارث التي صنعها الإنسان على جميع المستويات سواء محلية أو إقليمية أو دولية. فالأمن الإنساني يضع مجموعة من الأهداف التي ترتكز إلى الأفراد والتنمية من أجل صون كرامة الإنسان وتلبية حاجاته المادية والمعنوية، وتحقيق الأمن عن طريق اتباع سياسات تنموية حكيمة ورشيدة في كل المجالات.
وقد خصص المؤلف آخر محور في هذا الكتاب لتوضيح التصور الأمني لمرحلة ما بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر 2001، إذ يعتبر هذا الحدث تحولاً حاسماً في تاريخ العلاقات الدولية من خلال ما أنتجه من تغييرات بنيوية في النظام الدولي، برز من خلاله التصور الأميركي للأمن الذي تبني استراتيجية هجومية استباقية ووقائية لدرء المخاطر والقضاء على التهديدات الأمنية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وذلك كردة فعل على أحداث 11 أيلول – سبتمبر. وكانت نتيجة هذا التصور خوض سلسلة من الحروب في أفغانستان والعراق والتي كان نتاجها كوارث إنسانية وبيئية لا حصر لها.
وقد تعزز منظور التهديدات الأمنية الجديدة من خلال تجاوز مفاهيم الأمن التقليدية، من خلال التركيز على الأمن الجماعي وإعادة رسم الخريطة الأمنية العالمية وتبني استراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية بتصوراتها القديمة والجديدة خصوصاً مع الانتشار الواسع لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيث أن التهديدات الأمنية الجديدة لا تعترف بالحدود الوطنية.
لذلك يعتبر الأمن الجماعي بحسب المؤلف هو التصور الأمني الأبرز لمواجهة التحديات والتهديدات والأخطار الأمنية لما بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر.
ويخلص المؤلف إلى أن السلام والأمن باعتبارهما ظاهرة قديمة ومتجددة في نفس الوقت، كانا ولا يزالان مطلباً وضرورة إنسانية لتخليص البشرية من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات والعنف والإرهاب.
ومن صفوة القول، إنه كتاب مهم يستحق المتابعة، يؤسس للتأثيرات المتباينة لمنظورات السلام والأمن، باعتبارهما مركز ثقل في استقرار حياة الدولة.









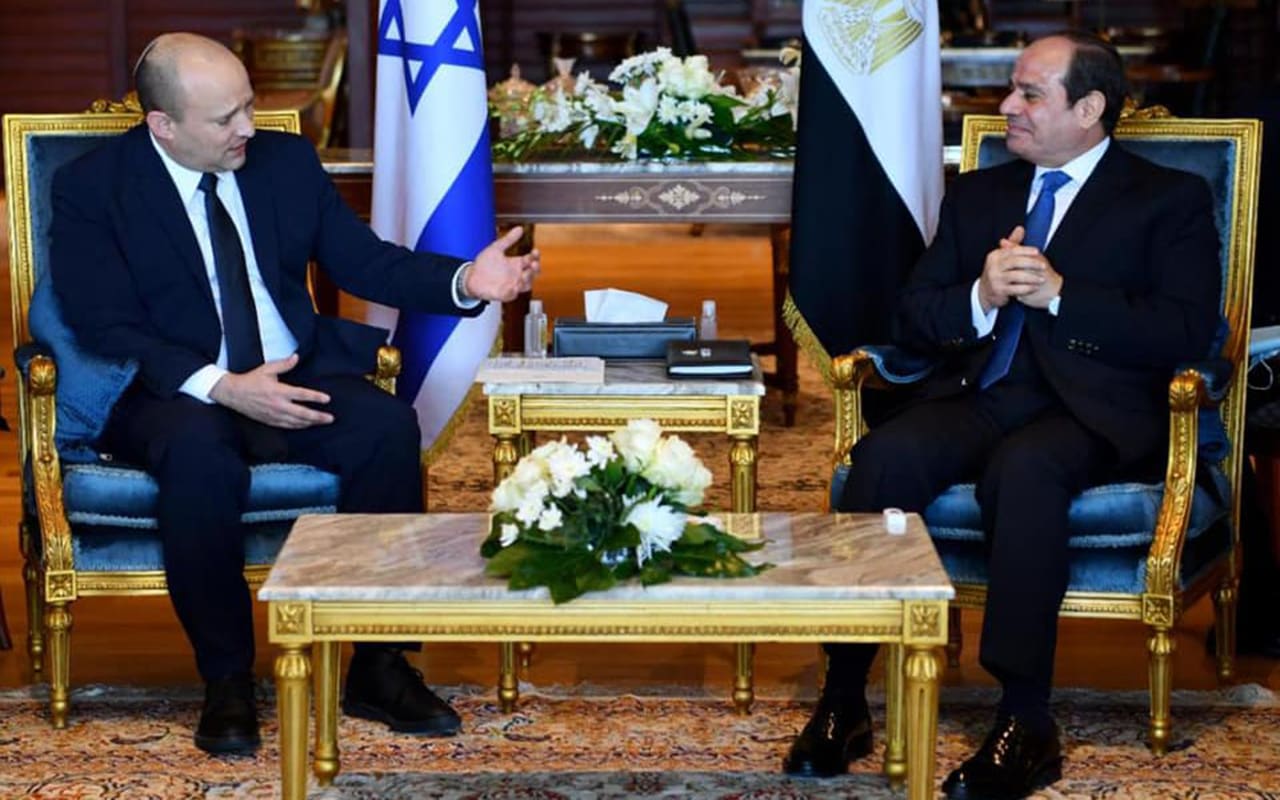












أضف تعليق