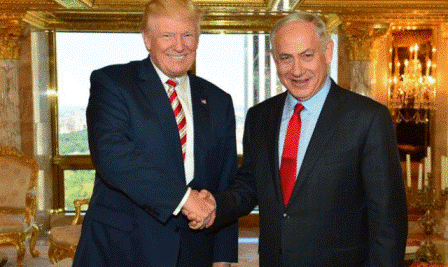
قوة «الصفقة».. وضعفها
لا يمكن إنكار مصادر قوة صفقة ترامب، وليست كلها مرتبطة بضعف من تستهدفهم، ونحن في المقدمة. ولا يمكن في الوقت نفسه تجاهل مواطن ضعفها وعوامل فشلها، ونحن أيضا في مقدمة هذه العوامل.
ربما يبتعد البعض عن الخوض في هذه المسألة من زاوية عدم الإعلان الأميركي الرسمي عنها، وبالتالي،عدم وضوح عناصرها ومقاصدها على نحو كامل، وأن ما رشح منها ما هو إلا «رأس جبل الجليد». وهذا غير دقيق.
وبعض الذين يقرون بوضوحها وتبلور مسار أهدافها، يتوزعون مابين موقفين متعاكسين: إما التسليم بسطوة مصدرها في ظل اتحادها مع المشروع الإسرائيلي،أو اعتبارها سيناريو مكررا لما سبقها من مشاريع حاولت تصفية الحقوق الفلسطينية والعربية، وأخفقت.
بين هذين التقديرين،نعتقد أن صفقة ترامب تمتلك مصادر دفع لا يستهان بها، لكنها تفتقد حتى الآن إلى السكة التي توصلها إلى كامل غاياتها.
اعتمدت صفقة ترامب بشأن التسوية على ثلاثة حوامل:
أولا: للولايات المتحدة «دور حاسم» في التسوية معترف به من قبل المرجعيتين السياسيتين للوفدين المفاوضين، الفلسطيني والإسرائيلي، ومقر به عبر الممارسة العملية من قبل «الرباعية الدولية» التي رسَّمها مجلس الأمن. وخلال الوقت المديد منذ انطلاق المفاوضات وفق «أوسلو»، راكمت الإدارات الأميركية المتعاقبة دراية كافية لتفاصيل الخلافات بين الوفدين حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا كله برسم الاطلاع والاستخدام من قبل إدارة ترامب في سياق إنتاج مقاربتها الخاصة.
ومن هذه الزاوية عمدت إدارة ترامب إلى تسريب عناوين نسبت لخطتها تتحدث عن اقتراحات حول الكيانية الفلسطينية المستقبلية ووضع القدس تستند إلى خطط سابقة طرحت بعضها إدارة كلينتون في قمة «كمب ديفيد 2» صيف العام 2000 وفشلت في فرضها على الجانب الفلسطيني، لتندلع بعد ذلك بأشهر قليلة «انتفاضة الاستقلال».
ثانيا: توافرت لإدارة ترامب حزمة من القرارات والتشريعات الأميركية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي اتخذها الكونغرس في عهد الإدارات السابقة ورسمت في إطار مجموعة من القوانين يتم تفعيلها بقرار من الرئيس، بينها ما يتصل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الأميركية بشأن المنظمات والمؤسسات والجهات الدولية والإقليمية والمحلية التي ترى أنها أخلت بشروط المساعدات التي تقدمها لها. وهذه القوانين وفرت لإدارة ترامب حجة القول بأنها لم تخرج عن المحددات التقليدية للسياسة الرسمية الأميركية،عندما نقلت السفارة إلى القدس وقطعت تمويل الأونروا ومعظم مساعدات السلطة الفلسطينية ومؤسسات أخرى تنشط في الضفة بما فيها القدس، وكذلك الأمر في مواصلة تهديداتها بالمزيد من هذه الإجراءات.
ثالثا : تعاملت إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو المستمرة تحت رئاسته منذ العام 2009 كحامل مهم لعناوين خطتها في المنطقة العربية،ووجدت في خطة نتنياهو «السلام الاقتصادي» انسجاما مع متطلبات مشروعها بخصوص«الحل الإقليمي»،الذي تعتزم فرضه. ولذلك كانت النتيجة اتحاد الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية والذي من تداعياته الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ولاحقا الاعتراف بسيادته على الجولان السوري المحتل، وهما سابقتان في السياسة الرسمية الأميركية اندفعت إدارة ترامب في ارتكابهما في تقدير بأن ردات الفعل تجاههما ستكون مسقوفة تحت وطأة الاختلال في موازين القوى لصالح الاحتلال وداعمه الأميركي، وفي ظل تداعيات الحروب الطاحنة التي تشهدها المنطقة العربية.
ومع اتحاد الرؤيتين المذكورتين بات الحديث يجري عن مشروع أميركي ـ إسرائيلي يتعامل من خلاله نتنياهو كشريك في التخطيط، وأكثر من ذلك في التنفيذ، على اعتبار أن الإجراءات والمواقف الأميركية في مسار الصفقة تمس مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية المباشرة للاحتلال.
بالمقابل، وبعد كل الإجراءات الأميركية التي اتخذت وما يرافقها من تطبيقات إسرائيلية على الأرض، يتبين للكثير من الأطراف الدولية والإقليمية أن الحديث الأميركي عن «حل الصراع» في المنطقة غير سوي، وأن ما يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسات هو انفجار الأوضاع، واتخاذ الصراع أبعادا غير مسبوقة، في ظل سياسة القطع التي تتبعها إدارة ترامب مع القواعد المعروفة لأية تسوية سياسية ناجزة حول قضية بحجم القضية الفلسطينية وتداعياتها العربية،مع استمرار إسرائيل باحتلال أراض لثلاث دول عربية بالاضافة لفلسطين.
وتتساءل أوساط سياسية دولية واقليمية عما تبقى في الجعبة الأميركية بعد كل ما أفرغته من مواقف وإجراءات وضغوط وتهديدات دون أن تعطي نتيجة عملية على الجبهة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن إدارة ترامب التي تحاول اللعب بالوقت وإشعال انتظار المستهدفين بجديد ما في خطتها، باتت هي تستثقل مرور هذا الوقت دون تحقيق الطرف الثاني المهم من المعادلة، وهو حضور الطرف الفلسطيني المستعد للخضوع لاستحقاقات الصفقة والتي تبدأ بتصفية القضية الفلسطينية.
ولقد فشلت سابقا، محاولات قامت بها إدارات أميركية سابقة في تمرير مبادرات هابطة عبر اللجوء إلى طرح مغريات بهدف تشجيع المفاوض الفلسطيني على إبرام اتفاق دائم لا ينسجم مع تلبية الحقوق الفلسطينية، لكن ذلك لم ينفع،لأن السم الذي وضع في الدسم كان يمس الخطوط الفلسطينية الحمر التي لا ولم يقوَ أحد على تجاوزها. فكيف الأمر اليوم وكل ما يقدم هو السم الزعاف؟
وإذا كان هذا الاعتبار يشكل عائقا مهما أمام الصفقة في ظل الوضع الفلسطيني المتردي القائم، فكيف الأمر في حال انتبهت الحالة الفلسطينية لأوضاعها ومضت على طريق تجاوز أزماتها عبر إنهاء الانقسام وإقفال باب الرهان على التسوية مع الاحتلال في ظل المعادلات القائمة.. وكيف يمكن لحكومة نتنياهو القائمة والقادمة أن تواصل ضغوطها الأمنية والاقتصادية والسياسية على الحالة الفلسطينية عندما يوضع الاحتلال في مكانه الحقيقي، وتقطع العلاقات معه ويسحب الاعتراف فيه، تطبيقا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وبالتالي ما هو موقف المجتمع الدولي الذي ما يزال يقف متفرجا على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل واعتقال ونهب للأراضي وهدم للبيوت، عندما تشتعل المقاومة الشعبية الفلسطينية في وجه الاحتلال ومستوطنيه ويقرر الفلسطينيون خوض معركة مفتوحة مع المحاولات المتلاحقة لإقفال باب مستقبلهم الوطني وتجسيد حقوقهم الوطنية؟
ما سبق ليس احتمالات وسيناريوهات افتراضية، بل محددات طريق مواجهة المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، وهذا ممكن .. وواجب.
ربما يبتعد البعض عن الخوض في هذه المسألة من زاوية عدم الإعلان الأميركي الرسمي عنها، وبالتالي،عدم وضوح عناصرها ومقاصدها على نحو كامل، وأن ما رشح منها ما هو إلا «رأس جبل الجليد». وهذا غير دقيق.
وبعض الذين يقرون بوضوحها وتبلور مسار أهدافها، يتوزعون مابين موقفين متعاكسين: إما التسليم بسطوة مصدرها في ظل اتحادها مع المشروع الإسرائيلي،أو اعتبارها سيناريو مكررا لما سبقها من مشاريع حاولت تصفية الحقوق الفلسطينية والعربية، وأخفقت.
بين هذين التقديرين،نعتقد أن صفقة ترامب تمتلك مصادر دفع لا يستهان بها، لكنها تفتقد حتى الآن إلى السكة التي توصلها إلى كامل غاياتها.
اعتمدت صفقة ترامب بشأن التسوية على ثلاثة حوامل:
أولا: للولايات المتحدة «دور حاسم» في التسوية معترف به من قبل المرجعيتين السياسيتين للوفدين المفاوضين، الفلسطيني والإسرائيلي، ومقر به عبر الممارسة العملية من قبل «الرباعية الدولية» التي رسَّمها مجلس الأمن. وخلال الوقت المديد منذ انطلاق المفاوضات وفق «أوسلو»، راكمت الإدارات الأميركية المتعاقبة دراية كافية لتفاصيل الخلافات بين الوفدين حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا كله برسم الاطلاع والاستخدام من قبل إدارة ترامب في سياق إنتاج مقاربتها الخاصة.
ومن هذه الزاوية عمدت إدارة ترامب إلى تسريب عناوين نسبت لخطتها تتحدث عن اقتراحات حول الكيانية الفلسطينية المستقبلية ووضع القدس تستند إلى خطط سابقة طرحت بعضها إدارة كلينتون في قمة «كمب ديفيد 2» صيف العام 2000 وفشلت في فرضها على الجانب الفلسطيني، لتندلع بعد ذلك بأشهر قليلة «انتفاضة الاستقلال».
ثانيا: توافرت لإدارة ترامب حزمة من القرارات والتشريعات الأميركية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي اتخذها الكونغرس في عهد الإدارات السابقة ورسمت في إطار مجموعة من القوانين يتم تفعيلها بقرار من الرئيس، بينها ما يتصل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الأميركية بشأن المنظمات والمؤسسات والجهات الدولية والإقليمية والمحلية التي ترى أنها أخلت بشروط المساعدات التي تقدمها لها. وهذه القوانين وفرت لإدارة ترامب حجة القول بأنها لم تخرج عن المحددات التقليدية للسياسة الرسمية الأميركية،عندما نقلت السفارة إلى القدس وقطعت تمويل الأونروا ومعظم مساعدات السلطة الفلسطينية ومؤسسات أخرى تنشط في الضفة بما فيها القدس، وكذلك الأمر في مواصلة تهديداتها بالمزيد من هذه الإجراءات.
ثالثا : تعاملت إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو المستمرة تحت رئاسته منذ العام 2009 كحامل مهم لعناوين خطتها في المنطقة العربية،ووجدت في خطة نتنياهو «السلام الاقتصادي» انسجاما مع متطلبات مشروعها بخصوص«الحل الإقليمي»،الذي تعتزم فرضه. ولذلك كانت النتيجة اتحاد الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية والذي من تداعياته الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ولاحقا الاعتراف بسيادته على الجولان السوري المحتل، وهما سابقتان في السياسة الرسمية الأميركية اندفعت إدارة ترامب في ارتكابهما في تقدير بأن ردات الفعل تجاههما ستكون مسقوفة تحت وطأة الاختلال في موازين القوى لصالح الاحتلال وداعمه الأميركي، وفي ظل تداعيات الحروب الطاحنة التي تشهدها المنطقة العربية.
ومع اتحاد الرؤيتين المذكورتين بات الحديث يجري عن مشروع أميركي ـ إسرائيلي يتعامل من خلاله نتنياهو كشريك في التخطيط، وأكثر من ذلك في التنفيذ، على اعتبار أن الإجراءات والمواقف الأميركية في مسار الصفقة تمس مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية المباشرة للاحتلال.
بالمقابل، وبعد كل الإجراءات الأميركية التي اتخذت وما يرافقها من تطبيقات إسرائيلية على الأرض، يتبين للكثير من الأطراف الدولية والإقليمية أن الحديث الأميركي عن «حل الصراع» في المنطقة غير سوي، وأن ما يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسات هو انفجار الأوضاع، واتخاذ الصراع أبعادا غير مسبوقة، في ظل سياسة القطع التي تتبعها إدارة ترامب مع القواعد المعروفة لأية تسوية سياسية ناجزة حول قضية بحجم القضية الفلسطينية وتداعياتها العربية،مع استمرار إسرائيل باحتلال أراض لثلاث دول عربية بالاضافة لفلسطين.
وتتساءل أوساط سياسية دولية واقليمية عما تبقى في الجعبة الأميركية بعد كل ما أفرغته من مواقف وإجراءات وضغوط وتهديدات دون أن تعطي نتيجة عملية على الجبهة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن إدارة ترامب التي تحاول اللعب بالوقت وإشعال انتظار المستهدفين بجديد ما في خطتها، باتت هي تستثقل مرور هذا الوقت دون تحقيق الطرف الثاني المهم من المعادلة، وهو حضور الطرف الفلسطيني المستعد للخضوع لاستحقاقات الصفقة والتي تبدأ بتصفية القضية الفلسطينية.
ولقد فشلت سابقا، محاولات قامت بها إدارات أميركية سابقة في تمرير مبادرات هابطة عبر اللجوء إلى طرح مغريات بهدف تشجيع المفاوض الفلسطيني على إبرام اتفاق دائم لا ينسجم مع تلبية الحقوق الفلسطينية، لكن ذلك لم ينفع،لأن السم الذي وضع في الدسم كان يمس الخطوط الفلسطينية الحمر التي لا ولم يقوَ أحد على تجاوزها. فكيف الأمر اليوم وكل ما يقدم هو السم الزعاف؟
وإذا كان هذا الاعتبار يشكل عائقا مهما أمام الصفقة في ظل الوضع الفلسطيني المتردي القائم، فكيف الأمر في حال انتبهت الحالة الفلسطينية لأوضاعها ومضت على طريق تجاوز أزماتها عبر إنهاء الانقسام وإقفال باب الرهان على التسوية مع الاحتلال في ظل المعادلات القائمة.. وكيف يمكن لحكومة نتنياهو القائمة والقادمة أن تواصل ضغوطها الأمنية والاقتصادية والسياسية على الحالة الفلسطينية عندما يوضع الاحتلال في مكانه الحقيقي، وتقطع العلاقات معه ويسحب الاعتراف فيه، تطبيقا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وبالتالي ما هو موقف المجتمع الدولي الذي ما يزال يقف متفرجا على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل واعتقال ونهب للأراضي وهدم للبيوت، عندما تشتعل المقاومة الشعبية الفلسطينية في وجه الاحتلال ومستوطنيه ويقرر الفلسطينيون خوض معركة مفتوحة مع المحاولات المتلاحقة لإقفال باب مستقبلهم الوطني وتجسيد حقوقهم الوطنية؟
ما سبق ليس احتمالات وسيناريوهات افتراضية، بل محددات طريق مواجهة المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، وهذا ممكن .. وواجب.




















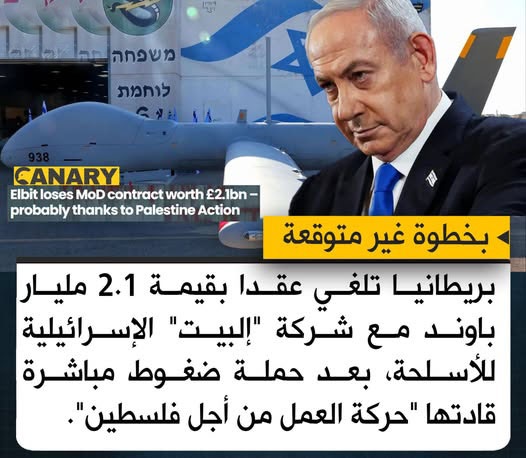

أضف تعليق