
لماذا يكرهون شعبهم؟
لماذا يكرهون شعبهم، وهو الذي دخل بتضحياته وعظمته كل بيت ومؤسسة ومحفل سياسي في هذا العالم؟
■ لم تفاجئنا حفلة القمع التي تعرض لها الحراك الشعبي في الضفة الفلسطينية عشية عيد الفطر، على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، وهو يدعو لإلغاء العقوبات الجماعية على أبناء القطاع. كذلك لم تفاجئنا المبررات الواهية والسخيفة التي قادها البعض للدفاع عن القمع، وللدفاع عن نكوث القيادة الفلسطينية بوعودها، أو انقلابها على قرارات المجلس الوطني، في عدم إعادة الحق لأصحابه، من موظفين ومستحقين في قطاع غزة.
كذلك لم تفاجئنا حفلة القمع التنكرية التي تعرض لها الحراك الشعبي في مدينة غزة، على يد أجهزة أمن حركة حماس، وهو يدعو أيضاً لإلغاء العقوبات. كذلك لم تفاجئنا المبررات والتفسيرات الواهية والمفبركة والسينمائية التي حاول الناطقون باسم الحركة الدفاع بها عن سياسة القمع.
اذ يبدو لنا، أن الطرفين، ينظران الى الحركة الشعبية الفلسطينية، نظرة استخدامية محدودة الأفق، هما معها، مادامت تؤيد سياسة كل منهما، ولا يترددان في مناصيتها العداء إن هي حاولت أن تتحلى بالاستقلالية وحرية إبداء الرأي وانتقاد الأخطاء والفساد في الإدارة والسياسية.
وليست هي المرة الأولى التي تتعرض لها الحركة الشعبية، هنا وهناك، للقمع على يد الأجهزة الأمنية، وأحياناً على يد «الميليشيا المسلحة» التي تحاول أن تتدخل باعتبارها «جزءاً من الحراك الشعبي»، في موقع المؤيد للسلطة. هنا باسم فتح، وهناك باسم حركة حماس. فالطرفان هما الممسكان بالسلطة والأقدر على اتخاذ القرار، وبالتالي ما من حدث أمني تتعرض له نشاطات الحركة الشعبية إلا وتكون السلطة (هنا وهناك) خلفه.
لكن خطورة ما جرى من قمع هذه المرة يختلف في سياقه السياسي عن سابقاته.
• فالحالة الفلسطينية في مجابهة مشروع سياسي خطير، يجري تطبيقه خطوة خطوة، في إطار التمهيد لإعلانه، وبحيث يعلن عنه عندما تكون عناصر تطبيقه قد باتت جاهزة اقليمياً، وفلسطينياً وإسرائيلياً. الأمر الذي يتطلب، بدلاً من الذهاب نحو العبث بالمؤسسات (على شاكلة العبث باللجنة التنفيذية من قبل المطبخ السياسي) وبدلاً من الذهاب الى معاقبة الشعب، بذريعة معاقبة حماس، وبدلاً من الذهاب لإخماد الحراك الشعبي، بذريعة «توفير الهدوء والأمان» خلال فترة الأعياد، أو بذريعة «الدفاع عن الشرعية» كان يفترض بالقيادة المسؤولة أن تلعب دور التجميع للقوى، والفعاليات، لا أن تفرق بينها، وأن تعزز نفوذها في الشارع، لا أن تستفز الشارع، وأن تعزز روح الائتلاف والشراكة الوطنية لا أن تندفع نحو الاستفراد والتفرد. وأن تعتمد عناصر القوة الفلسطينية أولاً وقبل كل شيء، لا أن تتجاهلها وأن تضعفها، بذريعة الرهان على الدور العربي وعلى الوعود الأوروبية. ولا ندري الى أي حد تعتقد القيادة الفلسطينية أنها، بسياستها القائمة على التفرد، وتهميش الآخرين، وتجاهلهم، وتهميش المؤسسة، مقتنعة أنها ستستطيع فعلا التصدي للمشروع الأميركي، أم أنها تعمل على بعثرة الصفوف، وإضعاف القوى، والدفع بالانقسام نحو محطات أكثر عمقاً، لتبرر خطواتها اللاحقة القائمة على الرهان على بقايا أوسلو، كما جاء في خطاب رئيس السلطة الفلسطينية في 20/2/2018، أمام مجلس الأمن داعياً الى استئناف مفاوضات الحل الدائم، متعهداً تجميد قرارات فك الارتباط باتفاق أوسلو.
* * *
من جانبها، يجب على حركة حماس ألا تتناسى أنها جزء من الإنقسام بينها وبين السلطة الفلسطينية، وبالتالي هي لم تبرأ من خطيئة إنقلاب 14/6/2007. وأنها تتحمل قسطاً من المسؤولية عما آل إليه قطاع غزة من تدهور في أوضاعه. وهي حتى الآن، لم تعتذر عما فعلت يداها، علماً أن المراجعات السياسية التي أجرتها في نيسان (2017) تعلن بوضوح أن الحركة أخطأت، وإن التراجع عن الخطأ فضيلة.
لكن التراجع عن الخطأ، لا لصون حركة حماس، وإخراجها من مأزقها السياسي، وتوفير فرص جديدة لمسارها الجديد، وإعادة تقديمها على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي في صيغة أكثر تطوراً. كل هذا مطلوب وكل هذا جيد، لكن اذا استند الى مراجعة نقدية علنية مازالت حتى الآن مغيبة في بعض الجوانب.
• فحماس مازالت تمارس سياسة سلطوية قمعية في لحظة تعتقد أنها ضرورية، ضد الحركة الشعبية. هذا السلوك يتناقض مع وروح الانتماء الى حركة تحرر تستند الى تأييد الشارع وقواه السياسية والاجتماعية لها. وما لجأت إليه في القمع الأخير، يؤكد أنها مازالت مدعوة لقطع شوط غير قصير للانتقال حقاً، من سلطة ذات نزعات سلطوية قمعية الى قوة سياسية مقاومة في عداد حركة التحرر الفلسطينية. هذه الازدواجية تلحق الضرر الكبير بحركة حماس.
• كما أن حماس مازالت تتحمل المسؤولية، الى جانب السلطة الفلسطينية في رام الله، في تعطيل قرارات إنهاء الانقسام. وارتكبت في هذا السياق أخطاء بررت أحياناً للسلطة في رام الله سياستها المعاندة. مثال الإصرار على حل فوري لحوالي 45 ألف موظف. ومثال آخر إصرارها على الاستفراد بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ورفضها اشراك القوى الوطنية في التحقيق. ما ألقى بظلال الشك على النتائج التي أعلنتها حماس، وتحولت القضية الى تراشق الاتهامات، وتعطيل لمسار إنهاء الانقسام، يتحمل مسؤوليته الطرفان، فتح وحماس، ويتحمل نتيجته المواطن في غزة بسبب العقوبات والحصار، كما يتحمل نتيجته المواطن في الضفة الفلسطينية بسبب تداعياته الفاسدة على مجمل الحالة الوطنية، وعلى فرص انهاض وتطوير الحراك الشعبي.
* * *
من مخاطر ما جرى، في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة، أن القمع من شأنه أن يبنى مسافة، «عدم ثقة» بين المواطن والسلطة، إن كانت السلطة الفلسطينية، أو سلطة الأمر الواقع.
ومن مخاطر ما جرى أن قد يحول حالة «عدم الثقة» الى نوع من الكراهية المتبادلة، والحقد المتبادل، بل والعداء المتبادل. الشارع يرى في أداة القمع ما يعفي سلطة الاحتلال من بعض وظائفها، وبحيث تتحول الأجهزة الأمنية الى «وكيل»، قد تنزلق في ممارساتها لتتجاوز حدود القوانين الدولية، بذرائع واهية، كالقول إننا تحت الاحتلال، وإننا خلف الحصار. ما يحول الاحتلال والحصار الى ذريعة للقمع بدلاً من أن يتحول الى سبب لتعزيز الوحدة الداخلية. وإذا ما افتقدت الحركة الشعبية ثقتها في الأجهزة الأمنية، معناه إضعاف روح الحراك الشعبي، وإضعاف روح المقاومة الشعبية وإحداث بلبلة في الشارع خاصة اذا ما بنيت المواقف على ردود فعل سريعة وعفوية.
واذا ما أصابت الأجهزة الأمنية حالة من الكراهية إزاء الحركة الشعبية انزلقت نحو مفاهيم ومعادلات، ترى في الحراك الشعبي شكلاً من الفوضى والتخريب، وبالتالي تتحول الأجهزة الأمنية الى وسيلة للقمع، مثلها مثل الأجهزة في الدول ذات الحكومات الاستبدادية، المتربعة على الحكم بقوة سلب إرادة الشعب وتعطيل عناصر القوة لديه.
كان من المتوقع أن تكون الحركة الشعبية في قطاع غزة قد حققت نقلة نوعية وتاريخية في تنظيمها مسيرات العودة وكسر الحصار، وكان من المتوقع أن تكون العقلية السائدة لدى سلطة الأمر الواقع في القطاع، قد تبدلت مع تصاعد الحراك الشعبي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى، والاستعداد العالي لأبناء القطاع لتقديم المزيد من التضحيات. لكن مثل هذه التوقعات أجهضتها حادثة القمع الأخيرة، بذريعة أنها حملت شعارات لا ترضي حماس.
وكان من المتوقع أيضاً أن يكون نهوض الحركة الشعبية في رام الله فاتحة لمرحلة جديدة، تتساوى فيها مستويات الحراك بين الإقليميين، بعدما طرحت العديد من التساؤلات عن سبب خفوت الحراك في الضفة. لكن كما يبدو، هناك من لا يريد للشارع أن يتحرك، بل هناك من يرغب في بقاء الشارع مستكيناً، خاصة في ظل إحساس ضمني لدى هذه القوى بمدى هشاشة موقع «الشرعية». فتحولت «الشرعية» و«صون الشرعية» الى هاجس يومي لديها، حتى أنها قمعت حراك الضفة بذريعة حماية الشرعية.
خلاصة هذا الكلام تعيدنا الى السؤال الأول:
لماذا يكرهون شعبهم، في وقت دخل فيه هذا الشعب بتضحياته وعظمته الى كل بيت، وكل محفل في هذا العالم؟■
■ لم تفاجئنا حفلة القمع التي تعرض لها الحراك الشعبي في الضفة الفلسطينية عشية عيد الفطر، على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، وهو يدعو لإلغاء العقوبات الجماعية على أبناء القطاع. كذلك لم تفاجئنا المبررات الواهية والسخيفة التي قادها البعض للدفاع عن القمع، وللدفاع عن نكوث القيادة الفلسطينية بوعودها، أو انقلابها على قرارات المجلس الوطني، في عدم إعادة الحق لأصحابه، من موظفين ومستحقين في قطاع غزة.
كذلك لم تفاجئنا حفلة القمع التنكرية التي تعرض لها الحراك الشعبي في مدينة غزة، على يد أجهزة أمن حركة حماس، وهو يدعو أيضاً لإلغاء العقوبات. كذلك لم تفاجئنا المبررات والتفسيرات الواهية والمفبركة والسينمائية التي حاول الناطقون باسم الحركة الدفاع بها عن سياسة القمع.
اذ يبدو لنا، أن الطرفين، ينظران الى الحركة الشعبية الفلسطينية، نظرة استخدامية محدودة الأفق، هما معها، مادامت تؤيد سياسة كل منهما، ولا يترددان في مناصيتها العداء إن هي حاولت أن تتحلى بالاستقلالية وحرية إبداء الرأي وانتقاد الأخطاء والفساد في الإدارة والسياسية.
وليست هي المرة الأولى التي تتعرض لها الحركة الشعبية، هنا وهناك، للقمع على يد الأجهزة الأمنية، وأحياناً على يد «الميليشيا المسلحة» التي تحاول أن تتدخل باعتبارها «جزءاً من الحراك الشعبي»، في موقع المؤيد للسلطة. هنا باسم فتح، وهناك باسم حركة حماس. فالطرفان هما الممسكان بالسلطة والأقدر على اتخاذ القرار، وبالتالي ما من حدث أمني تتعرض له نشاطات الحركة الشعبية إلا وتكون السلطة (هنا وهناك) خلفه.
لكن خطورة ما جرى من قمع هذه المرة يختلف في سياقه السياسي عن سابقاته.
• فالحالة الفلسطينية في مجابهة مشروع سياسي خطير، يجري تطبيقه خطوة خطوة، في إطار التمهيد لإعلانه، وبحيث يعلن عنه عندما تكون عناصر تطبيقه قد باتت جاهزة اقليمياً، وفلسطينياً وإسرائيلياً. الأمر الذي يتطلب، بدلاً من الذهاب نحو العبث بالمؤسسات (على شاكلة العبث باللجنة التنفيذية من قبل المطبخ السياسي) وبدلاً من الذهاب الى معاقبة الشعب، بذريعة معاقبة حماس، وبدلاً من الذهاب لإخماد الحراك الشعبي، بذريعة «توفير الهدوء والأمان» خلال فترة الأعياد، أو بذريعة «الدفاع عن الشرعية» كان يفترض بالقيادة المسؤولة أن تلعب دور التجميع للقوى، والفعاليات، لا أن تفرق بينها، وأن تعزز نفوذها في الشارع، لا أن تستفز الشارع، وأن تعزز روح الائتلاف والشراكة الوطنية لا أن تندفع نحو الاستفراد والتفرد. وأن تعتمد عناصر القوة الفلسطينية أولاً وقبل كل شيء، لا أن تتجاهلها وأن تضعفها، بذريعة الرهان على الدور العربي وعلى الوعود الأوروبية. ولا ندري الى أي حد تعتقد القيادة الفلسطينية أنها، بسياستها القائمة على التفرد، وتهميش الآخرين، وتجاهلهم، وتهميش المؤسسة، مقتنعة أنها ستستطيع فعلا التصدي للمشروع الأميركي، أم أنها تعمل على بعثرة الصفوف، وإضعاف القوى، والدفع بالانقسام نحو محطات أكثر عمقاً، لتبرر خطواتها اللاحقة القائمة على الرهان على بقايا أوسلو، كما جاء في خطاب رئيس السلطة الفلسطينية في 20/2/2018، أمام مجلس الأمن داعياً الى استئناف مفاوضات الحل الدائم، متعهداً تجميد قرارات فك الارتباط باتفاق أوسلو.
* * *
من جانبها، يجب على حركة حماس ألا تتناسى أنها جزء من الإنقسام بينها وبين السلطة الفلسطينية، وبالتالي هي لم تبرأ من خطيئة إنقلاب 14/6/2007. وأنها تتحمل قسطاً من المسؤولية عما آل إليه قطاع غزة من تدهور في أوضاعه. وهي حتى الآن، لم تعتذر عما فعلت يداها، علماً أن المراجعات السياسية التي أجرتها في نيسان (2017) تعلن بوضوح أن الحركة أخطأت، وإن التراجع عن الخطأ فضيلة.
لكن التراجع عن الخطأ، لا لصون حركة حماس، وإخراجها من مأزقها السياسي، وتوفير فرص جديدة لمسارها الجديد، وإعادة تقديمها على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي في صيغة أكثر تطوراً. كل هذا مطلوب وكل هذا جيد، لكن اذا استند الى مراجعة نقدية علنية مازالت حتى الآن مغيبة في بعض الجوانب.
• فحماس مازالت تمارس سياسة سلطوية قمعية في لحظة تعتقد أنها ضرورية، ضد الحركة الشعبية. هذا السلوك يتناقض مع وروح الانتماء الى حركة تحرر تستند الى تأييد الشارع وقواه السياسية والاجتماعية لها. وما لجأت إليه في القمع الأخير، يؤكد أنها مازالت مدعوة لقطع شوط غير قصير للانتقال حقاً، من سلطة ذات نزعات سلطوية قمعية الى قوة سياسية مقاومة في عداد حركة التحرر الفلسطينية. هذه الازدواجية تلحق الضرر الكبير بحركة حماس.
• كما أن حماس مازالت تتحمل المسؤولية، الى جانب السلطة الفلسطينية في رام الله، في تعطيل قرارات إنهاء الانقسام. وارتكبت في هذا السياق أخطاء بررت أحياناً للسلطة في رام الله سياستها المعاندة. مثال الإصرار على حل فوري لحوالي 45 ألف موظف. ومثال آخر إصرارها على الاستفراد بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ورفضها اشراك القوى الوطنية في التحقيق. ما ألقى بظلال الشك على النتائج التي أعلنتها حماس، وتحولت القضية الى تراشق الاتهامات، وتعطيل لمسار إنهاء الانقسام، يتحمل مسؤوليته الطرفان، فتح وحماس، ويتحمل نتيجته المواطن في غزة بسبب العقوبات والحصار، كما يتحمل نتيجته المواطن في الضفة الفلسطينية بسبب تداعياته الفاسدة على مجمل الحالة الوطنية، وعلى فرص انهاض وتطوير الحراك الشعبي.
* * *
من مخاطر ما جرى، في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة، أن القمع من شأنه أن يبنى مسافة، «عدم ثقة» بين المواطن والسلطة، إن كانت السلطة الفلسطينية، أو سلطة الأمر الواقع.
ومن مخاطر ما جرى أن قد يحول حالة «عدم الثقة» الى نوع من الكراهية المتبادلة، والحقد المتبادل، بل والعداء المتبادل. الشارع يرى في أداة القمع ما يعفي سلطة الاحتلال من بعض وظائفها، وبحيث تتحول الأجهزة الأمنية الى «وكيل»، قد تنزلق في ممارساتها لتتجاوز حدود القوانين الدولية، بذرائع واهية، كالقول إننا تحت الاحتلال، وإننا خلف الحصار. ما يحول الاحتلال والحصار الى ذريعة للقمع بدلاً من أن يتحول الى سبب لتعزيز الوحدة الداخلية. وإذا ما افتقدت الحركة الشعبية ثقتها في الأجهزة الأمنية، معناه إضعاف روح الحراك الشعبي، وإضعاف روح المقاومة الشعبية وإحداث بلبلة في الشارع خاصة اذا ما بنيت المواقف على ردود فعل سريعة وعفوية.
واذا ما أصابت الأجهزة الأمنية حالة من الكراهية إزاء الحركة الشعبية انزلقت نحو مفاهيم ومعادلات، ترى في الحراك الشعبي شكلاً من الفوضى والتخريب، وبالتالي تتحول الأجهزة الأمنية الى وسيلة للقمع، مثلها مثل الأجهزة في الدول ذات الحكومات الاستبدادية، المتربعة على الحكم بقوة سلب إرادة الشعب وتعطيل عناصر القوة لديه.
كان من المتوقع أن تكون الحركة الشعبية في قطاع غزة قد حققت نقلة نوعية وتاريخية في تنظيمها مسيرات العودة وكسر الحصار، وكان من المتوقع أن تكون العقلية السائدة لدى سلطة الأمر الواقع في القطاع، قد تبدلت مع تصاعد الحراك الشعبي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى، والاستعداد العالي لأبناء القطاع لتقديم المزيد من التضحيات. لكن مثل هذه التوقعات أجهضتها حادثة القمع الأخيرة، بذريعة أنها حملت شعارات لا ترضي حماس.
وكان من المتوقع أيضاً أن يكون نهوض الحركة الشعبية في رام الله فاتحة لمرحلة جديدة، تتساوى فيها مستويات الحراك بين الإقليميين، بعدما طرحت العديد من التساؤلات عن سبب خفوت الحراك في الضفة. لكن كما يبدو، هناك من لا يريد للشارع أن يتحرك، بل هناك من يرغب في بقاء الشارع مستكيناً، خاصة في ظل إحساس ضمني لدى هذه القوى بمدى هشاشة موقع «الشرعية». فتحولت «الشرعية» و«صون الشرعية» الى هاجس يومي لديها، حتى أنها قمعت حراك الضفة بذريعة حماية الشرعية.
خلاصة هذا الكلام تعيدنا الى السؤال الأول:
لماذا يكرهون شعبهم، في وقت دخل فيه هذا الشعب بتضحياته وعظمته الى كل بيت، وكل محفل في هذا العالم؟■



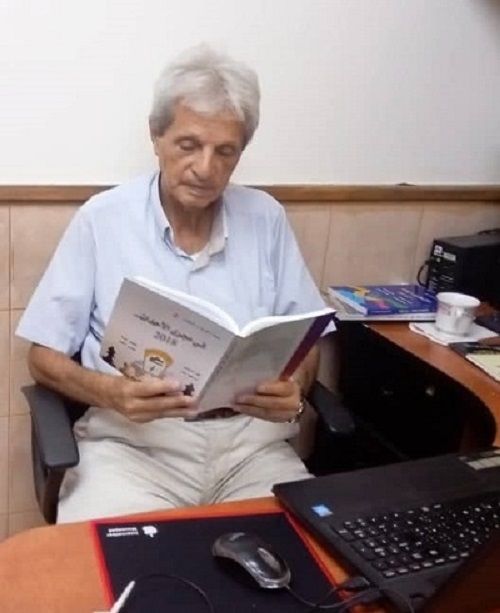









أضف تعليق