
على دوار "المنارة"..!
تدور الرواية الوحيدة التي حلمتُ بكتابتها يوماً، حول شارع "رُكَب"، ولكن إحدى المشكلات، وقوع الشارع في رام الله، ويبدأ من دوار الأسود المشهور باسم "دوار المنارة"، على أنّ الدوار الصغير، الذي لا يلتزم أحد بقواعد المرور عليه، يتوسط مدينتي البيرة ورام الله، والقصة على الجانبين. وبالتالي يفضل عنونة الرواية المتخيلة بـ"على دوار المنارة"؛ فأجمع جناحي الدّوار/ المدينتين/ الشارعين، و"ثنائيات" أخرى.
ترمز تماثيل الأُسود إلى أبناء عائلة راشد صقر الحدادين، الذي هاجر وعائلته من الكرك، في القرن السادس عشر، مرورا بإقامة مؤقتة في حلحول قرب الخليل، وصولا لخربة رام الله حيث أسس المدينة الحديثة.
يمكن بدء الرواية بسيدة أوقفتني يوماً، في الجناح البيراوي من الشارع، وقالت "ما أجمل هذه النسمات"، مشيرة للهواء، فأجبت موافقاً مستغرباً لماذا استوقفتني وخاطبتني. ثم قالت المهم أن لا يقوموا ببناء عمارة جديدة هنا، وبدأت تتحدث وتشير لكل بناية وتخبرني ماذا كان مكانها من بيوت جميلة قبل تحول "المدينتين"، إلى "عاصمة السلطة"، فتهدم البيوت لصالح البنايات التجارية العالية. واتضح أنّها عائدة من 50 سنة غربة في الولايات المتحدة، حيث تزوجت، ولحسن حظي، كنتُ هناك في لحظة النوستالجيا تلك. ولكن هذا في البيرة، أما في رام الله فيجب الحديث عن المكان الذي كانت فيه ساحة البلدة ونبع الماء ومكان الأعراس، وتشغله الآن بناية بشعة ومحطة بنزين.
لكن الرواية التي تغريني حقاً، تبدأ من قبل مخيطة في الطابق الثالث، في بناية مطلة على الدوار؛ حيث كان يجتمع في السبعينيات، خياط وحارس في جامعة بيرزيت ومعهما أستاذ بيولوجيا، ويقودون العمل المناضل. وسيبلغونني وسط أكوام قصص بطولية، عن مناضلة تحرش بها مدّعو نضال، وعن يوم قام عملاء بالهجوم على قيادات "الشبيبة" في المخيطة، وتصدوا لهم وسال "بحر" من الدم. ثم سأمر بالدوار، وأتحدث عن شخص أعدمه شباب في انتفاضة الأقصى، لأنه "عميل"، ولكنه لم يعترف بالعمالة، وبقيت عمالته موضع شك. وسألتفت نحو ما كان يوماً سينما الوليد وأقفل في زمن الانتفاضة الأولى.
ثم للبناية التي فيها الدكانة الوحيدة التي تبيع مجلات ودوريات عربية وعالمية في المدن الفلسطينية.
قبل أعوام في 2014، خرجت باكراً، مُبيّتاً في نفسي، سحب نقود من الصراف الآلي الوحيد لبنكي قبل الازدحام، والذهاب للدوار لشرب القهوة، ممن يقفون مع الفجر هناك، مستهدفين شريحة العُمال. وعندما وصلتُ كان المشهد بالغ الغرابة، جعلني أفقد التركيز؛ حجارة صغيرة، اسمنتية، أغلبها من أنقاض مبانٍ مهدومة، تنتشر على مد النظر، كسجادة. وبدأت بتصوير المشهد، عندما أبلغني شاب، "اذهب وصور الشهيد". سألته أين؟ فوق المبنى المقابل للوردة الحمراء (محل بيع زهور).
أخبرت أحد أصدقائي من طلابي في الجامعة، بما حدث، فأخذني في جولة: "هذه البناية التي جاءها الجيش يعتقل شابا من "الجهاد" كان في محل انترنت فيها، وأقفلوا باب البناية بعربتهم، فبدأ الشباب بقصفهم بالحجارة والنتيجة، تَمكُن "الجهادي" من الإفلات، وسقوط شهداء بين الشباب". ثم أُكمِل الطريق؛ هنا صالون الشعر الذي اصطدم به زميلي وسام وكسر زجاجه، قبل اختفائه مطارداً تسع سنوات. ومقابل محل ركب للبوظة، حيث كان بنك ليئومي، ونفذ أبو علاء وشقيقه وأصدقاؤه العملية الشهيرة العام 1974، قبل هربه عبر النهر إلى إربد، حيث صار ضمن لجنة "الـ77" المسؤولة عن الخلايا السرية في الداخل. وهنا المدرسة التي كان يعمل ويحب فتاة فيها، يتمنى الارتباط بها. وفي "رام الله التحتا"، تتناثر اليافطات، هنا استشهد القائد فلان، وهنا البطل فلان. وهنا يخبرني الحلاق وهو يقص شعري كيف فتح محله وخرج بمظاهرة قبل أعوام من ولادتي، مطالباً أحمد الشقيري بالتسليح.
عندما سقط شهيد "الوردة الحمراء"، كان الشباب غاضبا جداً، لماذا لم يشاركه أفراد الأمن الفلسطيني، بالتصدي للاختراق الإسرائيلي؟. في الأربعاء الفائت الحزين، اصطدم الأمن بمن فيه من مناضلين، ومعهم "مدنيون"، مع مناضلين من أسرى محررين، وأسيرات، ومناضلين حاليين، ومقاتلين سابقين، خرجوا يعبرون عن رؤيتهم بشأن ما يحدث في غزة، وانتشر الغاز في محيط الدوار.
للشارع ماضٍ قد يُنبت يوماً زهر حنونٍ في ثناياه، رُوي بالحب والعرق والدم ومن لا يحفظه سيندم كثيراً.



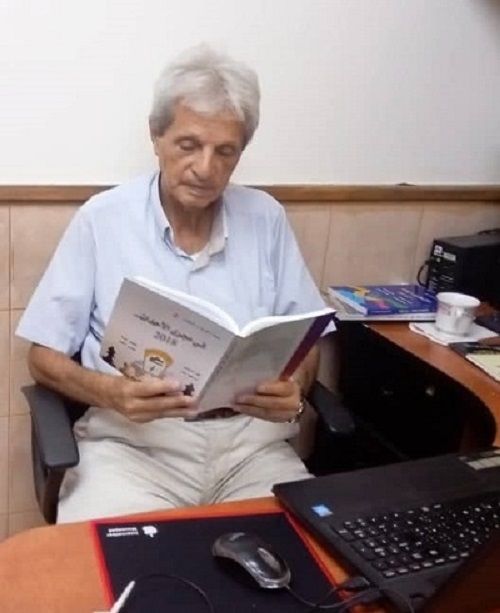









أضف تعليق