
عن قرارات «المركزي» وضرورات «الوطني» الجديد
■ لو توفرت في أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها محكمة دستورية عليا، لأمكن إحالة خطاب رئيس السلطة في مجلس الأمن (20/2/2018) عليها، ومساءلته عن دستورية ما جاء فيه من اقتراحات وأفكار ومواقف ومبادرات. لكن القضاء في السلطة الفلسطينية، مازال تابعاً للإدارة السياسية، يلتزم مواقفها، ولا يعارضها، ولم تتوفر له، حتى الآن، الدرجة الكافية من الاستقلالية التي تمكنه من التحرر من الضغوط السياسية، وإصدار أحكام محايدة، فيها القدر المطلوب من العدالة. ولعل العديد من الحوادث تؤكد صحة رأينا، خاصة إذا ما راجعنا عدداً من الوقائع القضائية التي مازالت الضفة الفلسطينية تعيش تداعياتها السلبية.
لو توفرت المحكمة الدستورية، التي نطمح أن تقوم يوماً ما، لأمكن وضع خطاب 20/2/2018 على طاولة التشريح، وإدارة نقاش سياسي حر، بشأنه، تحت قوس العدالة، وتبيان مدى التزامه قرارات الشرعية الفلسطينية، كما رسمتها المؤسسات الوطنية، خاصة المجلس المركزي الفلسطيني في دوريته الأخيرتين (5/3/2015 و 15/1/2018) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأمكن مساءلة رئيس السلطة الفلسطينية عن مصدر صلاحياته، وفيما إذا كانت صلاحيات بلا حدود، وبلا ضوابط، وبلا مرجعية قانونية مؤسساتية، خاصة وأنه، كما يفترض أن يكون قد أقسم، حين توليه السلطة على الالتزام القوانين وعدم مخالفتها والقفز عنها، وانتهاكها.
* * *
جوهر القضية هو أننا قارنّا خطاب مجلس الأمن، بقرارات المجلس المركزي، فوجدناه مخالفاً له، ولا يلتزمه، ووجدنا «المبادرة» الواردة فيه، لا تحترم قرارات المركزي، ولا تلتزمها، بل تسير وفقاً لالتزامات اتفاق أوسلو. بل إن الإشارات إلى اتفاق أوسلو ونصوصه كانت واضحة وصريحة، لا تحتاج التأويل لتظهيرها.
وبالتالي من حق أي مواطن فلسطيني، وكذلك من حق أي مراقب أن يسأل، بإسم من جرى تقديم خطاب مجلس الأمن، ومن هي الهيئة الرسمية التي صاغته، أو ناقشته، أو وافقت عليه، خاصة أنه لم يعرض لا على المجلس المركزي، ولا على اللجنة التنفيذية، ولا على اللجنة المركزية لحركة فتح نفسها.
المفارقة في الأمر أنه، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل وتهميش المؤسسة الوطنية خاصة المجلس المركزي، وقراراته، واللجنة التنفيذية وقراراتها، تبرر القيادة الرسمية الفلسطينية على عجلة من أمرها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وبإصرار، وبصيغته القديمة، التي مضى عليها زمن طويل، خاصة وأن آخر جلسة يعقدها هذا المجلس، كانت 1996 انعقدت في ظل انقسام فلسطيني عميق، سببه الذهاب إلى أوسلو من خلف المؤسسات ومن خلف الفصائل، ومن خلف الشعب وبالتالي، وفي ظل الانقسامات أدخلت عليه تعديلات بقرارات فردية دون التشاور مع الفصائل، ودون أي احترام لمبادئ الائتلاف الوطني والتشاركية.
والدعوة للمجلس الوطني القديم، تشكل في حد ذاتها تهميشاً للجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت وفي عمان، ولكل الأعمال التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الزعنون، لإعادة بناء مجلس وطني جديد، بالانتخابات الحرة والنزيهة وبقانون التمثيل النسبي الكامل، وبحيث يكون مجلساً جامعاً لكل أطياف الحالة السياسية الفلسطينية، وإطاراً توحيدياً لكل فئات الشعب الفلسطيني.
وبشيء من التدقيق يتبدى لنا أن المنطق الذي قاد إلى خطاب في مجلس الأمن، يقفز عن مواقف التوافق والإجماع الوطني، وينكفئ إلى سياسة التفرد والاستفراد، وسياسة الرأي الواحد، وسياسة مخالفة مبادئ الوحدة الوطنية، هو نفسه المنطق الذي يصر على مجلس وطني قديم، يرمز إلى الانقسام، وإلى التفتت، ويصر على استبعاد الانتخابات التي من شأنها أن تعيد بناء المؤسسة على أسس ديمقراطية بعيداً عن سياسة الهيمنة وسياسة التفرد بالقرار.
وبالتالي نحن نخوض، في الحالة الفلسطينية، وفي إطار معركتنا الوطنية ضد الاحتلال، معارك داخلية، عبر الأطر وفي الميدان، لأجل تحقيق قرارات الهيئات، لكن مع الإدراك، في الوقت نفسه، أنه لا يمكن للغة الوحدة الوطنية، ولغة الائتلاف الوطني، ولغة التشاركية أن تنتصر دون إدخال الإصلاحات الديمقراطية الواسعة على المؤسسة، ودون مغادرة سياسة الفك والتركيب الفوقي، والقائمة على ضمان الهيمنة الفردية، وضمان التسلط على الهيئات، وتحويلها إلى هياكل فارغة من مضمونها.
* * *
الهيئات والمؤسسات الوطنية بصيغتها الحالية هي نتاج مرحلة سياسية في الحالة الفلسطينية ولت وانقضت. هي هيئات ومؤسسات تمت عملية تركيبها بقرارات فوقية، في سياق إنقسامي، أرادت منها القيادة الرسمية أن تضمن لنفسها «الأكثرية العددية» لقراراتها، وأن كانت هذه «الأكثرية» لا تشكل «أكثرية سياسية». الأكثرية العددية، هي أكثرية مفبركة، هدفها ضمان هيمنة القيادة الرسمية على الهيئات، فيما لو تم اللجوء إلى التصويت. أما «الأكثرية السياسية» فهي الأكثرية القائمة على التوافق الوطني والإجماع الوطني. ومثال على ذلك «وثيقة الوفاق الوطني للعام 2006» التي شكلت عنواناً باهراً للأكثرية السياسية. ومثال على ذلك «اتفاق أوسلو»، الذي مثل عنواناً بائساً «للأكثرية العددية»، وهي الأكثرية التي جرى تحشيدها في المجلس الوطني في جلستيه في العام 1996، وفي غزة بحضور الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون لإلغاء الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبالتالي أن ما تطمح القيادة الرسمية لتكراره، في المجلس الوطني القديم، هو ضمان بقاء القديم على قدمه، وبقاء هيمنة الأكثرية العددية على الأكثرية السياسية وضمان بقاء ودوام سياسة الاستفراد والتفرد، والتفلت من قيود المؤسسة وقيود قراراتها.
وما حصل في مجلس الأمن هو واحد من الثمار المرة لهذا الواقع المؤسساتي البالي في الحالة الفلسطينية.
المؤسف، على سبيل المثال، أن ينبري أكثر من عضو في المجلس المركزي، وفي اللجنة التنفيذية، ممن صوتوا لصالح قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، لكيل المديح لخطاب مجلس الأمن. الإشادة بالمبادرة التي وردت فيه رغم أنها مبنية على اتفاق أوسلو، وتدعو لاستكمال مفاوضات أوسلو، وتقفز عن قرار المجلس المركزي بفك الارتباط بهذا الاتفاق وفك الارتباط بالصيغة التفاوضية القديمة، لصالح صيغة جديدة تتبناها وترعاها الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والمؤسف، في السياق نفسه، أن مثل هذا السلوك، بات يشكل حالة «طبيعية» في البنية السياسية الفلسطينية، تميل حيث تميل القيادة الرسمية الفلسطينية، دون أدنى اعتبار للرأي العام، ولمشاعر الناس ولعقولها
أن مثل هذه السياسات البهلوانية في رسم المواقف والقرارات، هي التي أفقدت الشارع ثقته بقيادته الرسمية، وهي التي أفقدته ثقته بالمؤسسة الفلسطينية. وهي التي نزعت اليقين بجدية القيادة الرسمية في مجابهة قرارات إدارة ترامب والسياسات الإسرائيلية.
فعلى سبيل المثال، علق كثيرون على قرارات «المركزي» في الدورة الأخيرة كأنها مجرد حبر على ورق. واستندوا في ذلك إلى تجربتهم المرة مع قرارات «المركزي» في الدورة السابقة (5/3/2015).
ولا نبالغ إذا ما قلنا أن معظم الفلسطينيين لا يبدون أي اهتمام باجتماعات اللجنة التنفيذية، لأنهم يعتقدون، وهو اعتقاد صحيح وسليم، أنها إذا اجتمعت خرجت من دون قرارات، وأنها إذا ما اتخذت قراراً ما، بقيت قراراتها حبراً على ورق.
خلاصة الكلام، معركة الدفاع عن الأرض، والشعب، والوطن؛
هي نفسها معركة صون قرارات المؤسسة الوطنية والنضال لأجل تنفيذها؛
هي نفسها معركة الإصلاح الديمقراطي للمؤسسة الوطنية، بالانتخابات الحرة والديمقراطية، وبقانون التمثيل النسبي الكامل، لإعادة الاعتبار للشارع، باعتباره صاحب القرار، وطي صفحة سياسة التفرد والاستفراد، وقد كان خطاب مجلس الأمن واحداً من ثمارها المرة.■
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: index/article.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/alhottcr/alhourria_ps/application/views/templates/index/article.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/alhottcr/alhourria_ps/application/controllers/Article.php
Line: 85
Function: view
File: /home/alhottcr/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

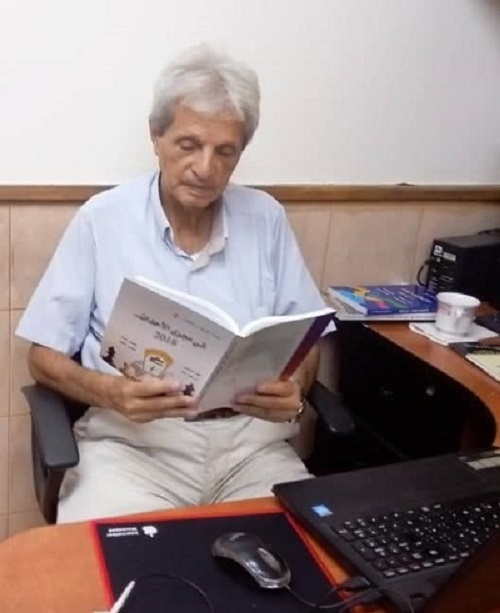














أضف تعليق